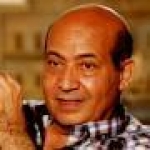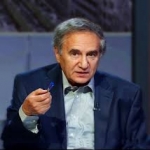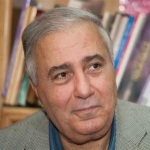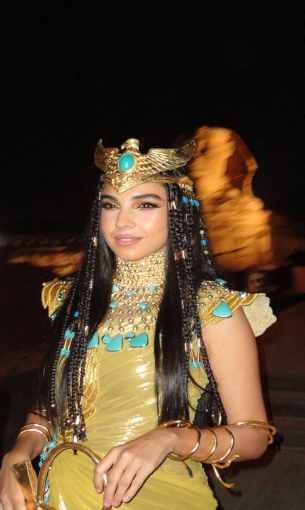الرئيسية
أخبارعاجلة
رياضة
- الأخبار الرياضية
- أخبار الرياضة
- فيديو أخبار الرياضة
- نجوم الملاعب
- أخبار الرياضة
- ملاعب عربية وعالمية
- بطولات
- أخبار الأندية العربية
- مقابلات
- رياضة عربية
- رياضة عالمية
- موجب
- سالب
- مباريات ونتائج
- كرة الطائرة
- كرة اليد
- كرة السلة
- رمي
- قفز
- الجري
- تنس
- سيارات
- غولف
- سباق الخيل
- مصارعة
- جمباز
- أخبار المنتخبات
- تحقيقات
- مدونات
- أخبار المحترفين
- غاليري
ثقافة
إقتصاد
فن وموسيقى
أزياء
صحة وتغذية
سياحة وسفر
ديكور
أجيال .. وأجيال
أجيال .. وأجيال

بقلم : د. وحيد عبدالمجيد
استمتعت بنقاش مع شاب مجتهد يعمل باحثًا مساعدًا فى مركز «الأهرام» للدراسات السياسية والاستراتيجية حول العلاقة بين الأجيال وقضايا أخري. سألنى عن رأيى فى اعتقاد كثير من الباحثين الأقدم فى العلوم الاجتماعية بأن ملكاتهم البحثية أقوى من نظيراتها لدى الأجيال الأحدث. قلت إننى أوافقهم لسبب موضوعى لا يتعلق بقدرات هؤلاء وأولئك، وهو أن الباحثين من الأجيال الأقدم وجدوا صعوبات كبيرة فى إنجاز أبحاثهم. لا تُقارن هذه الصعوبات بما يواجه الأجيال الأحدث. لم تكن هناك شبكة «إنترنت» ولا محركات البحث مثل «جوجل» وغيره مما هو متاح الآن.
كان على الباحثين من الأجيال الأقدم أن يركبوا الصعب لإنجاز أبحاثهم. أذكر مثلاً أننى كنت أجوب المكتبات العامة بحثًا عن كتاب أو آخر إذا لم يتوافر فى مكتبة مركز «الأهرام». كانت مكتبات الجامعات ودار الكتب أماكن مألوفة لدى كثير من الباحثين الأقدم. فى المقابل يستطيع الباحث الآن أن يجد الكتاب الذى يريده إلكترونيًا خلال دقائق، بينما كان البحث عن كتاب قبل ذلك يستغرق يومًا كاملاً أو أكثر. وهذا مثال واحد للفروق بين بيئة عمل الباحثين من الأجيال الأقدم والأحدث. لم يكن فى إمكان الأقدم أن يستسهلوا، فلم يكن هناك شيء سهل فى عملهم. كما أن عدد الباحثين قبل أربعة وخمسة عقود كان قليلاً جدًا مقارنة بما صار عليه الآن. ولذا كانوا تحت مجهر قراء ومتابعين كُثُر. كان عليهم التدقيق إلى أقصى مدى إذا أرادوا نيل استحسان من يتابع أعمالهم. لا يوجد مثل ذلك الآن، الأمر الذى يحرم الأجيال الأحدث من نعمة نقد أعمالهم، ومن ثم دفعهم إلى مزيد من الإجادة. سألنى الباحث الشاب أيضًا عن النقاش الذى يحدث أحيانًا حول المدخل إلى البحث العلمى فى العلوم الاجتماعية، وهل هو الإطار النظرى أم المشكلة البحثية. قلت له إننى أبدأ البحث بتحديد المشكلة البحثية وأعدُّها بمنزلة المفتاح الذى أدخل بواسطته إلى منطقة البحث، ثم أستخدم أطراً نظرية بمقدار الحاجة إليها. والحال أنه قليل الآن مثل هذا الحوار بين أجيال مختلفة.
GMT 12:01 2025 الخميس ,06 تشرين الثاني / نوفمبر
صدقوني إنها «الكاريزما»!GMT 11:53 2025 الخميس ,06 تشرين الثاني / نوفمبر
إحياء الآمال المغاربيةGMT 11:50 2025 الأربعاء ,05 تشرين الثاني / نوفمبر
النار في ثياب ترامبGMT 11:40 2025 الخميس ,06 تشرين الثاني / نوفمبر
.. وفاز ممدانيGMT 11:07 2025 الخميس ,06 تشرين الثاني / نوفمبر
التاريخ والجغرافيا والمحتوىGMT 10:59 2025 الخميس ,06 تشرين الثاني / نوفمبر
مرة أخرى.. قوة دولية فى غزة !GMT 10:56 2025 الخميس ,06 تشرين الثاني / نوفمبر
حلم المساواةGMT 10:24 2025 الخميس ,06 تشرين الثاني / نوفمبر
عرفان وتقديرالصين تعلّق جزءاً من الرسوم الجمركية على السلع الأميركية وسط توتر تجاري مستمر مع واشنطن
بكين - العرب اليوم
أعلنت الصين، الأربعاء، تعليق الرسوم الجمركية الإضافية البالغة 24% على السلع الأميركية لمدة عام واحد، مع الاحتفاظ برسوم بنسبة 10% على هذه السلع، في خطوة تهدف إلى التخفيف من حدة التوترات التجارية مع الولايات المتحدة. ك...المزيدأحمد حلمي وهند صبري يلتقيان في فيلم جديد للمخرج عمر هلال بعنوان "أضعف خَلقه"
القاهرة ـ العرب اليوم
أعلن المخرج المصري عمر هلال عن مشروعه السينمائي الجديد بعنوان "أضعف خَلقه"، الذي يجمع لأول مرة بين النجمين أحمد حلمي وهند صبري في تجربة فنية ينتظرها جمهور السينما المصرية بشغف. ويأتي هذا الفيلم بعد النجاح الكب...المزيدإيلون ماسك يطلق ميزة جديدة في غروك لتحليل منشورات منصة إكس
واشنطن - العرب اليوم
كشف الملياردير الأميركي إيلون ماسك عن ميزة رائعة بات "غروك"، مساعد الذكاء الاصطناعي المطور من شركة "إكس إيه آي" الناشئة، يقدمها إلى الملايين من مستخدمي منصة "إكس" حول العالم. فقد أعلن ماسك، في فيديو ن...المزيدإصابة أشرف حكيمي تبعده عن الملاعب وتثير القلق حول مشاركته في كأس الأمم الإفريقية
باريس ـ العرب اليوم
Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2025 ©
Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2025 ©