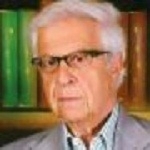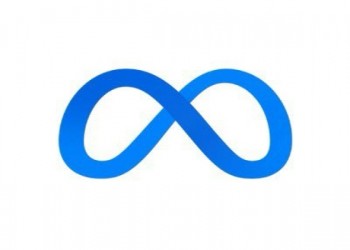الرئيسية
أخبارعاجلة
رياضة
- الأخبار الرياضية
- أخبار الرياضة
- فيديو أخبار الرياضة
- نجوم الملاعب
- أخبار الرياضة
- ملاعب عربية وعالمية
- بطولات
- أخبار الأندية العربية
- مقابلات
- رياضة عربية
- رياضة عالمية
- موجب
- سالب
- مباريات ونتائج
- كرة الطائرة
- كرة اليد
- كرة السلة
- رمي
- قفز
- الجري
- تنس
- سيارات
- غولف
- سباق الخيل
- مصارعة
- جمباز
- أخبار المنتخبات
- تحقيقات
- مدونات
- أخبار المحترفين
- غاليري
ثقافة
إقتصاد
فن وموسيقى
أزياء
صحة وتغذية
سياحة وسفر
ديكور
السوق الحُرة
السوق الحُرة

بقلم : د. وحيد عبدالمجيد
السوق عند الناس هى المكان الذى يبيعون فيه أو يشترون السلع. أما مفهوم السوق فيعنى الساحة الواسعة التى يتعامل فيها كل من يعملون ليس بالتجارة فقط، بل بمختلف الأنشطة الاقتصادية والمالية. ويعود أصل هذا المفهوم إلى المفكر الاقتصادى البريطانى آدم سميث فى القرن الثامن عشر، خاصةً فى كتابه الضخم ذى الأجزاء الخمسة «بحوث فى طبيعة ثروات الأمم ومسبباتها» الذى أُصدرت طبعته الأولى عام 1776. يبدو هذا الكتاب اليوم بسيطًا فى أفكاره التى مازال بعض الساسة والاقتصاديين مؤمنين بها. وأهم هذه الأفكار أن حرية السوق هى المدخل لزيادة ثروات الأمم، وأن المصلحة العامة تتحقق من خلال مجموع المصالح الشخصية للأفراد. ولكن رغم أن سميث كان مغاليًا فى دفاعه عن حرية السوق ونقده دور سلطة الدولة فى تنظيمها، فهو يبدو معتدلاً حين نقارنه ببعض رواد الليبرالية الجديدة وأنصارها. فالسوق الحُرة عندهم هى التى تضمن وجود مجتمع مدنى فاعل يستطيع تنظيم نفسه دون تدخل فى تفاعلاته. وهى أيضًا الساحة التى تتجسد فيها حرية البشر وتظهر فيها قدراتهم وملكاتهم. ويتمسك أنصار الليبرالية الجديدة بطروحاتهم التى لم يثبت معظمها. فعلى سبيل المثال ليس هناك ما يؤكد وجود علاقة طردية بين المجتمع المدنى ومجتمع السوق، أو وجود علاقة عكسية بين حرية السوق وتدخل سلطة الدولة لتنظيمها، طالما أنها لا تسيطر عليها. وأكثر من ذلك فهذا التدخل يبدو ضروريًا لحماية حرية السوق فى حالة حدوث احتكارات ثبت أنها تؤدى إلى تراكم الثروات على حساب هذه الحرية. وكما فى الحاضر كما فى الماضي. فلم يكن مفهوم السوق الحُرة عند سميث منسجمًا مع تجربة بريطانيا الناجحة فى زمنه. فقد انتفض البرلمان الإنجليزى ضد نظام الامتيازات الذى فرضه الملك وأدى إلى ظهور ما يُعرف اليوم بالاحتكارات التى كانت فى وقته، وفى كل وقت، حاجزًا أمام توسع النشاط الاقتصادي. فقد أدى نجاح البرلمان فى الدفع باتجاه التدخل لمواجهة تلك الامتيازات وما اقترن بها من احتكارات إلى إنعاش السوق بخلاف ما افترضه سميث.
GMT 07:57 2026 الثلاثاء ,10 شباط / فبراير
ردّة أخلاقيةGMT 07:55 2026 الثلاثاء ,10 شباط / فبراير
أميركا... ثقافة قديمة وعاديةGMT 07:53 2026 الثلاثاء ,10 شباط / فبراير
عن الحالتين الفلسطينية والسودانيةGMT 07:52 2026 الثلاثاء ,10 شباط / فبراير
لبنان... جولة جنوبية للطمأنةGMT 07:50 2026 الثلاثاء ,10 شباط / فبراير
تشخيص طبيعة الصراع بين أميركا وإيرانGMT 07:49 2026 الثلاثاء ,10 شباط / فبراير
تركيا و«شيفرون»... رهان أنقرة الجديد في عالم الطاقةGMT 07:47 2026 الثلاثاء ,10 شباط / فبراير
لبنان... المطلوب إصلاح جذري قبل الانتخاباتGMT 07:45 2026 الثلاثاء ,10 شباط / فبراير
هل ينجح ترمب في تفكيك قنبلة نتنياهو؟تراجع معدل التضخم في مدن مصر لـ 11.9% خلال شهر يناير
القاهرة ـ العرب اليوم
أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عن تراجع معدل التضخم في مدن مصر إلى نسبة 11.9% على أساس سنوي في يناير 2026 من قراءة ديسمبر025 2والبالغ نسبتها 12.3%. وأشار الجهاز المركزي للإحصاء إلى أن معدل التضخم الشهري في مصر �...المزيدأصالة تكشف تفاصيل ألبومها السوري الجديد ومشاركتها في رمضان 2026
الشارقة ـ العرب اليوم
أحيت الفنانة أصالة حفلًا غنائيًا في مدينة خورفكان بإمارة الشارقة، وعلى هامش الحفل عقدت مؤتمرًا صحفيًا تحدثت خلاله عن أحدث مشاريعها الفنية، سواء الغنائية أو الدرامية، كاشفة عن تفاصيل ألبومها السوري الجديد، إلى جا�...المزيدنظر دعوى قضائية تتهم شركات ميتا ويوتيوب بالتسبب في أضرار للأطفال
واشنطن ـ العرب اليوم
بدأت محكمة أمريكية في دراسة دعوى قضائية مثيرة للجدل تتهم شركتي ميتا ويوتيوب بالإضرار بالأطفال من خلال محتوى منصاتهما الرقمية. وتستند الدعوى إلى مزاعم بأن المنصات لم تتخذ التدابير الكافية لحماية المستخدمين الصغار ...المزيدجهود مؤسسية لحماية التراث في ندوة ثقافية بأيام الشارقة التراثية
جهود مؤسسية لحماية التراث في ندوة ثقافية بأيام الشارقة التراثية
الشارقة ـ العرب اليوم
على هامش فعاليات أيام الشارقة التراثية، استعرضت دائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي جهودها المؤسسية في صون التراث الثقافي وتعزيز التعليم الثقافي، وذلك خلال ندوة نظمها المقهى الثقافي في بيت النابودة بعنوان «الجهو...المزيد Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2025 ©
Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2025 ©