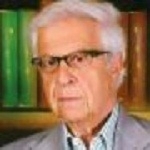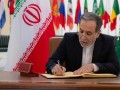الرئيسية
أخبارعاجلة
رياضة
- الأخبار الرياضية
- أخبار الرياضة
- فيديو أخبار الرياضة
- نجوم الملاعب
- أخبار الرياضة
- ملاعب عربية وعالمية
- بطولات
- أخبار الأندية العربية
- مقابلات
- رياضة عربية
- رياضة عالمية
- موجب
- سالب
- مباريات ونتائج
- كرة الطائرة
- كرة اليد
- كرة السلة
- رمي
- قفز
- الجري
- تنس
- سيارات
- غولف
- سباق الخيل
- مصارعة
- جمباز
- أخبار المنتخبات
- تحقيقات
- مدونات
- أخبار المحترفين
- غاليري
ثقافة
إقتصاد
فن وموسيقى
أزياء
صحة وتغذية
سياحة وسفر
ديكور
ممرٌ ترابي في اتجاهين
ممرٌ ترابي في اتجاهين

بقلم : جمعة بوكليب
صورتان لافتتان للاهتمام؛ إحداهما قديمة، مجمّدة في ذاكرتي، تعودُ إلى زمن الحرب العالمية الثانية، والأخرى منشورة في صحيفة بريطانية، التُقطت حديثاً، بعد يومين أو 3 على الأكثر من توقف حرب الإبادة الإسرائيلية في غزّة مؤخراً.
في الأولى يظهر مشهد طوابير طويلة لأناس من مختلف الأعمار، من الجنسين، نازحين من بيوتهم، في بقعة من أوروبا، يسيرون بين ركامٍ وأنقاضٍ وخرائب مدينة دمّرتها الحرب، برؤوس مطأطئة، وبظهور محنيّة، يجرّون وراءهم عربات خشبية صغيرة تحمل ما تبقّى لهم من متاع، في طريقهم إلى مجهول بانتظار ابتلاعهم.
في الصورة الثانية، يظهر ممرٌ ترابيٌ ضيق في مدينة غزّة، على جانبيه تظهر أنقاضٌ وركامُ مبانٍ مهدّمة بفعل القصف الإسرائيلي الجوّي والأرضي، تعيد إلى الأذهان صور مدينة هيروشيما اليابانية عقب القصف النووي الأميركي. على الممر الترابي الصغير يرى الناظر أناساً يسيرون في الاتجاهين. ولأن الصورة التُقطت من مكان مرتفع وبعيد، فإنهم يبدون مثل أشباح.
الاختلاف بين الصورتين هو أن الناس في الصورة المجمّدة في ذاكرتي كانوا نازحين ومشردين يجرجرون أقدامهم بيأس وتعب ومشقّة، لكن في اتجاه واحد، أي نحو مجهول. في الصورة الثانية، يظهر الناس يسيرون في الممر الترابي الصغير، بين الأنقاض والركام، في الاتجاهين؛ الأمر الذي يترك انطباعاً لدى الناظر بأنّهم، رغم الخراب والدمار المحيط بهم، مقيمون في المكان، وحريصون على ممارسة حيواتهم، وكأن ما يحيط بهم من خراب ليس باعثاً على اليأس والفرار.
لدى المقارنة بين الصورتين بتأمل، تبدو الأمور واضحة جليّة. على عكس ما يبدو في الصورة الأولى للنازحين من الحرب، يتبين للناظر أن من يبدون كأنهم أشباح سائرون على الممر الترابي الصغير في غزّة بالاتجاهين، ليسوا أشباحاً، بل بشر من دم ولحم وأحلام، يسيرون باحثين عما تبقّى لهم بين الخرائب، رافضين تركها والنزوح أو الهجرة إلى مكان آخر. الصورة تجسيد للعلاقة الجدلية بين الإنسان والمكان؛ بين الذاكرة من جهة، والتاريخ والجغرافيا من جهة أخرى... بين أن تكون أو لا تكون.
صورة الغزّيين بين خرائب مدينتهم توثّق المقاومة الإنسانية ضد الاحتلال، ورفض التسليم أو الهزيمة، والتشبث بالبقاء في الأرض التي ينتمون إليها وتمنحهم اسمها وملامحها وهوّياتهم، حتى بعد أن استحالت ركاماً وأنقاضاً. وفي الوقت ذاته، تحمل رسالة إلى الغازي المحتل وللعالم بأنّهم باقون.
اختيار البقاء بين تلك الأنقاض المخيفة ورفض الرحيل، يعني حرفياً هزيمة الغازي وجيوشه وسلاحه. من جهة أخرى، ربما يكون البقاء ليس خياراً، بل مصير وقدر، خصوصاً حين يكون البحر من أمامك والعدو من ورائك. وبدلاً من رفع راية التسليم والفرار بالنزوح، تقرر بوعي البقاء. في قطاع غزّة، كان الغزيون بين الأمرين، فقرروا البقاء، وعدم التفريط في الأرض من تحت أقدامهم ولو كانت خراباً صفصفاً.
الغزّيون في الصورة الثانية ليسوا أشباحاً ولن يكونوا. قبل الحرب كانوا غير مرئيين بفعل آلة إعلامية صهيونية ضخمة حجبتهم، وخلال الحرب اكتشفهم العالم، ورأى مأساتهم ومعاناتهم، وأضحى يحترمهم ويتعاطف معهم، ويتظاهر لأجلهم في كبرى عواصم العالم، ويرتدي كُوفِيَّتَهُم؛ رمزهم، ويرفع علمهم. هم، الآن، رمز ونموذج في آن للإنسان المغبون المقاوم الذي يرفض الهزيمة والخنوع، معلناً عن وجوده وحقّه في الحياة الكريمة، رغم ما يحيط به من يباب، وما يسكن قلبه من أحزان ومواجع وآلام تراكمت بالفقد والثكل، وبالحرمان من أبسط الحقوق الإنسانية المكفولة لغيرهم.
الإنسان - كما أوجزه قول العجوز «سنتياغو»، بطل رواية «العجوز والبحر» للكاتب الأميركي الراحل إرنست هيمنغواي - قد يتحطم، لكن لا يُهزم. والغزّيون أثبتوا ذلك في صمودهم غير المسبوق أمام جيش احتلال. ومقاومتهم وصمودهم يعيدان إلى الأذهان ما حدث في الجزائر وجنوب أفريقيا وليبيا، حيث دُحر الغزاة المستوطنون وعادت الأرض لأصحاب الأرض.
إنها المقاومة ضد الاحتلال في أكبر صورها تجليّاً، بعدم التفريط في حق الحياة، والانتماء إلى مكان ولسان وتاريخ وجغرافيا، أي إلى هوّية... والحق في الدفاع عن النفس، بمعنى أن يسمو الإنسان في المحن، بتأكيده على حبّ الحياة حتى في أحلك الظروف وأسوئها، وبالإعلان عن وجوده من خلال رفضه التفريط في حقوقه، ويظهر في صور، تنشرها وسائل الإعلام الدولية يومياً، وهو يسير في ممر ترابي صغير بالاتجاهين، محاطاً بأنقاضٍ وركامٍ وخرائب، ومحاصراً - برّاً وبحراً وجوّاً - من العدو، ليؤكد على حقيقة مهمة؛ هي أن الانتصار على الحجر لا يعني هزيمة الإرادة.
GMT 06:37 2026 الثلاثاء ,27 كانون الثاني / يناير
شروط القمرةGMT 06:34 2026 الثلاثاء ,27 كانون الثاني / يناير
بداية النهاية للترمبية كما تزعم «واشنطن بوست»؟!GMT 06:32 2026 الثلاثاء ,27 كانون الثاني / يناير
ما بعد دافوس: من طمأنينة التحالف إلى إدارة المخاطرGMT 06:29 2026 الثلاثاء ,27 كانون الثاني / يناير
تشويه الإصلاح مقامرة بلبنان!GMT 06:27 2026 الثلاثاء ,27 كانون الثاني / يناير
روح السعودية الجديدة تكمن في إدارة الحركةGMT 06:23 2026 الثلاثاء ,27 كانون الثاني / يناير
الطاقة في الأراضي الفلسطينيةGMT 06:21 2026 الثلاثاء ,27 كانون الثاني / يناير
عن تقلّبات الطقس والسياسةGMT 06:19 2026 الثلاثاء ,27 كانون الثاني / يناير
الولادات شاغلة البال عربياً ودولياًترامب يصعّد ضد سيول ويرفع الرسوم على سلع كوريا الجنوبية
واشنطن - العرب اليوم
أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الاثنين، عزمه رفع الرسوم الجمركية على سلع كورية جنوبية مختلفة، منتقداً سيول لعدم التزامها باتفاقية تجارية سابقة أبرمتها مع واشنطن. وكتب ترامب على منصته "تروث سوشال": "بما...المزيدماغي بوغصن تكشف تطور الدراما اللبنانية وتروي صعوبات طفولتها وتجاربها التعليمية والإبداعية
القاهرة ـ العرب اليوم
حلّت الفنانة ماغي بوغصن ضيفةً على برنامج "صاحبة السعادة"، الذي تقدّمه الفنانة إسعاد يونس على قناة dmc، حيث تحدثت عن رؤيتها للوسط الفني، مميزاته وتحدياته، مؤكدةً أن الساحة الفنية شهدت تطوراً كبيراً خلال السنوات...المزيدروس كوسموس تطوّر منظومة جديدة لمراقبة سلامة المركبات الفضائية والأقمار الصناعية
موسكو - العرب اليوم
طوّرت مؤسسة "روس كوسموس"، منظومة جديدة ستستخدم في مراقبة المركبات الفضائية والأقمار الصناعية للتحقق من سلامة هياكلها أثناء تواجدها في الفضاء. وقالت المؤسسة إن المنظومة الجديدة التي تدعى "نظام التصوير المس...المزيدملاحقات قضائية جديدة في إيران تشمل المثقفين والمقاهي على خلفية الاحتجاجات
طهران - العرب اليوم
فيما تتواصل الملاحقات القضائية بحق عدد من الموقوفين خلال الاحتجاجات التي عمت إيران خلال الفترة الماضية، أعلنت النيابة العامة فتح قضايا جديدة ضد شخصيات من عالمي الرياضة والثقافة. فقد أطلق مكتب المدعي العام في طهرا...المزيد Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2025 ©
Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2025 ©