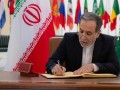الرئيسية
أخبارعاجلة
رياضة
- الأخبار الرياضية
- أخبار الرياضة
- فيديو أخبار الرياضة
- نجوم الملاعب
- أخبار الرياضة
- ملاعب عربية وعالمية
- بطولات
- أخبار الأندية العربية
- مقابلات
- رياضة عربية
- رياضة عالمية
- موجب
- سالب
- مباريات ونتائج
- كرة الطائرة
- كرة اليد
- كرة السلة
- رمي
- قفز
- الجري
- تنس
- سيارات
- غولف
- سباق الخيل
- مصارعة
- جمباز
- أخبار المنتخبات
- تحقيقات
- مدونات
- أخبار المحترفين
- غاليري
ثقافة
إقتصاد
فن وموسيقى
أزياء
صحة وتغذية
سياحة وسفر
ديكور
واشنطن: الإكثار من الخصوم سياسة مُكلفة وخطرة
واشنطن: الإكثار من الخصوم سياسة مُكلفة وخطرة

بقلم : إياد أبو شقرا
كانَ مثيراً إعلانُ ماركو روبيو، وزيرِالخارجية الأميركي، فرضَ عقوباتٍ على منظماتٍ تعمل علَى توثيقِ الجرائمِ والتجاوزات الإسرائيلية في قطاع غزةَ. وجاءَ هذا الإعلان، بعد أيامٍ من انعقاد قمة «منظمة شانغهاي للتعاون» التي شاركت فيها ثلاثُ قوى كبرى هي الصّين وروسيا والهند، وخطت باتجاه تفاهماتٍ لا يستبعد أن يكونَ المتضرّر الأكبرُ منها... الولايات المتحدة!
في «واشنطن دونالد ترمب»، صارَ «توثيقُ» الجرائم هو الأمرَ الفظيعَ الذي يستحقّ عقوباتٍ، لا ارتكابها... وهي التي تندرج فظاعتُها بين الإبادة الجماعية للمدنيين والتطهير العرقي جهاراً نهاراً.
نتفهّم، من خبرة تمتدّ لأكثرَ من سبعة عقود، «العلاقة الخاصة جداً» بين واشنطن وكل مَن حكمَ إسرائيلَ خلال هذه العقود. ولذا، لا يمكن لعاقل التصوّر، ولو للحظة، أن تُساوي «مؤسسة السلطة» الأميركية في «تعاملها» بين الكيانِ الإسرائيلي وأيِّ كيان آخرَ في الشرق الأوسط.
مع هذا، ينبغي التذكير بأنَّ بعض الإدارات الأميركية تصرّف في الماضي «بحزم من مُنطلق الحرص والود» إزاءَ تطاول قيادات التطرف الإسرائيلي. وحقاً، كانت تلك الإدارات تستشعر خطرَ المتطرفين الإسرائيليين على مستقبل كيانهم، فتتحرّك لزجرِهم من أجل مصلحتهم، في منطقة لطالما زعموا أنَّهم فيها محاصرون بـ«بحر من العرب والمسلمين».إبّانَ «حرب السويس» عام 1956، وقفت واشنطن إبان حكم دوايت آيزنهاور مع الاتحاد السوفياتي ضد «العدوان الثلاثي» الإسرائيلي – البريطاني – الفرنسي على مصر. وعام 1991، واجه وزير الخارجية الأميركي، جيمس بيكر، رئيس الحكومة الإسرائيلي (آنذاك) إسحاق شامير. وعندما رفض الأخير أي بحث بتطبيق القرارين الدوليين 242 و338، وناورَ و«تشاطر»، خاطبه بيكر بغضب «إذا رغب الإسرائيليون بالتجاوب مع جهود السلام وتطبيق القرارات الدولية، فهذا رقمُ هاتفِ البيت الأبيض، اتَّصلوا بنا»!...
هذانِ الموقفانِ صدرَا، في الحقيقة، عن إدارتين أميركيتين جمهوريتين... أين منهما إدارةُ الرئيسِ ترمب اليوم؟!
الحزبُ الجمهوري أيامَ آيزنهاور (1953-1961)، وأيامَ جورج بوش «الأب» (1989-1993)، كانَ «خيمة وطنية واسعة» تجمع سياسياً تياراتٍ محافظةً وليبراليةً معتدلة، وشخصياتٍ يمينيةً ووسطية.
وكانَ أيضاً حزباً يحترم تداولَ السلطة، ويثمّنُ المؤسساتِ الديمقراطية، ومبدأ الفصلِ بين السلطات، والتفاهماتِ الوطنية العريضة.حينذاك، لم يسقطِ «الشارع» الأميركي في «هستيرية متطرفة» يجسّدها اليوم حركيّو «ماغا»، ولم تستند التعيينات الحكومية والقضائية إلى الولاء الشخصي الأعمَى... بل إلى الكفاءةِ والخبرةِ والاحترام.
دولياً، كانتْ للولايات المتحدة مصالحُ سياسيةٌ واستراتيجيةٌ واضحة، في صميمِها العلاقات الأطلسية وتحالفات شرق آسيا. وكانت معاييرُ العداء والتحالف أكثرَ منطقية ووضوحاً وحسماً. وفي الشّق الاقتصادي المالي، كان مفهومُ «الاقتصاد الحر» يقوم فعلياً على التنافسية والنجاعة المالية وفتحِ الأسواق، لا على «التمترس» الكيدي وراء الإجراءات الحمائية و«حروب الرسوم الجمركية»... في اقتصادٍ معَولَم عالي التقنية ومتداخل المكوّنات والعلاقات والمصالح.
محلّلون أميركيون وأجانبُ يرون أنَّ ما تعيشه الولايات المتحدة، راهناً، مرحلة تطرح العديد من علامات الاستفهام. إذ لم يَعُدِ الخلاف محصوراً بالاستراتيجيات المالية والنقدية، حيث التناقض علني بين الرئيس ترمب و«غريمه» جيروم باول، محافظ الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي). وحيالَ تعريف «الصديق» و«العدو» في المجالين السياسي والاستراتيجي، ثمة ما يشبه الفوضى المؤذية التي تنفّر الحلفاء والأصدقاء و«الجيران»، من دون تحقيق تقاربات مفيدة مع المنافسين، أو تحييد الخصوم، أو الخروج بتصورات لدور «الأحادية القطبية الأميركية»... المهدّدة من عدة مصادر.
قمة «منظمة شنغهاي للتعاون»، التي نظّمت أخيراً في مدينة تيانجين الصينية - والتي تضمّ دولها نحو نصف سكان العالم - سلّطت الضوء على تقارب ما كان متوقعاً بين العملاقين الآسيويين الصين والهند. إذ بين العملاقين توتراتٌ حدودية قديمة العهد، وحالياً هناك التنافس الاستراتيجي بين مشروع «الحزام والطريق» الصيني ومشروع «الممر الاقتصادي بين الهند والشرق الأوسط وأوروبا» (إيميك). ولا شك في أنَّ «حرب» الرسوم الجمركية الأميركية ضد الهند أسهمت كثيراً في التقارب بين حكومتي نيودلهي وبكين.
ومن جانب آخر، كسر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، واقعياً، عبر التقارب مع الصين والهند، أي قيمة للمقاطعة الأميركية والدولية بسبب «الحرب الأوكرانية». ولعلَّ «انتصار» موسكو المعنوي هذا سيفاقم أزمةَ الثقة على الصعيد الأطلسي بين واشنطن وشريكاتها الأوروبيات. ومعلوم، أنَّ مطالبات ترمب لهذه الدول – وعلى رأسها ألمانيا – بزيادة إنفاقها في ميزانية الحلف، وكذلك تقاربه مع بوتين، ومطالبته بجزيرة غرينلاند... كانت من المواقف التي وتّرت الأجواء وهزّت الثقة عبر المحيط الأطلسي.
إنَّ سياسات ترمب، التي لا تعبأ بالإكثار من خصوم واشنطن والتقليل من عدد حلفائها، سياسات مكلفة وخطرة.
وهي بينما تهدّد استمرار الهيمنة الأميركية عالمياً، نجد المنافسين والخصوم يتقاربون باتجاه خلق «نظام عالمي» جديد ورسم خرائط نفوذ بديلة.
مواجهة مستقبل كهذا... سيكون صعباً بتقويض معاهد التعليم والأبحاث، وإضعاف الجهود العلمية والبحثية، ورهن مصالح واشنطن الدولية بإرضاء أضيق القواعد المصلحية وأبعدها عن الانفتاح والتعايش...
التقدم لا يعني العيشَ في الماضي، وعالم الغد سيكون حتماً غير عالم اليوم...
GMT 05:08 2026 الإثنين ,26 كانون الثاني / يناير
سرُّ حياتهمGMT 05:07 2026 الإثنين ,26 كانون الثاني / يناير
رفعت الأسد… أحد رموز الدولة المتوحّشةGMT 05:05 2026 الإثنين ,26 كانون الثاني / يناير
الإصلاح المستحيل: لماذا لا يملك خامنئي منح واشنطن ما تريد؟GMT 05:01 2026 الإثنين ,26 كانون الثاني / يناير
وأخيرا استجابت الهيئة..لا للأحزاب الدينيةGMT 04:59 2026 الإثنين ,26 كانون الثاني / يناير
المباراة المثاليةGMT 04:58 2026 الإثنين ,26 كانون الثاني / يناير
«مجلس ترامب».. أى مستقبل ينتظره؟!GMT 04:56 2026 الإثنين ,26 كانون الثاني / يناير
كرة الثلج الأسترالية والسوشيال ميدياGMT 04:55 2026 الإثنين ,26 كانون الثاني / يناير
المعاون الأنيس للسيد الرئيسالذهب يتجاوز 5000 دولار للأونصة ويواصل صعوده التاريخي وسط موجة من القلق العالمي
واشنطن ـ العرب اليوم
وصل سعر الذهب إلى مستوى قياسي جديد، متجاوزاً 5000 دولار للأونصة يوم الاثنين، مواصلاً بذلك صعوداً تاريخياً مع إقبال المستثمرين على هذا الأصل كملاذ آمن وسط تصاعد حالة عدم اليقين الجيوسياسي. وارتفع سعر الذهب الفوري بن�...المزيددنيا بطمة تكشف كواليس وأصعب اللحظات في فترة سجنها وتستعرض قوتها وشخصيتها الإيجابية
الرباط ـ العرب اليوم
دنيا بطمة، المطربة المغربية، عادت إلى الظهور الإعلامي بعد فترة من انتهاء أزمة سجنها وعودتها إلى الحياة الطبيعية، وفتحت دنيا بطمة قلبها للجمهور في لقائها مع قناة "المشهد"، وتحدثت عن كواليس وأسرار فترة سجنها وأ...المزيدتيك توك تطلق شركة تابعة في الولايات المتحدة لحماية خصوصية المستخدمين الأميركيين
واشنطن ـ العرب اليوم
أعلنت منصة "تيك توك" عن إنشاء شركة تابعة لها في الولايات المتحدة، مملوكة بأغلبية أسهمها لعدد من الشركات الأمريكية الكبرى، وذلك لحماية خصوصية المسخدمين الأمريكيين. وذكرت الشركة في بيان صحفي: "اليوم، وبموجب أ...المزيدملاحقات قضائية جديدة في إيران تشمل المثقفين والمقاهي على خلفية الاحتجاجات
طهران - العرب اليوم
فيما تتواصل الملاحقات القضائية بحق عدد من الموقوفين خلال الاحتجاجات التي عمت إيران خلال الفترة الماضية، أعلنت النيابة العامة فتح قضايا جديدة ضد شخصيات من عالمي الرياضة والثقافة. فقد أطلق مكتب المدعي العام في طهرا...المزيد Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2025 ©
Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2025 ©