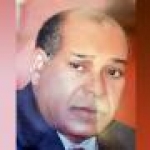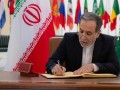الرئيسية
أخبارعاجلة
رياضة
- الأخبار الرياضية
- أخبار الرياضة
- فيديو أخبار الرياضة
- نجوم الملاعب
- أخبار الرياضة
- ملاعب عربية وعالمية
- بطولات
- أخبار الأندية العربية
- مقابلات
- رياضة عربية
- رياضة عالمية
- موجب
- سالب
- مباريات ونتائج
- كرة الطائرة
- كرة اليد
- كرة السلة
- رمي
- قفز
- الجري
- تنس
- سيارات
- غولف
- سباق الخيل
- مصارعة
- جمباز
- أخبار المنتخبات
- تحقيقات
- مدونات
- أخبار المحترفين
- غاليري
ثقافة
إقتصاد
فن وموسيقى
أزياء
صحة وتغذية
سياحة وسفر
ديكور
طه حسين .. وحافظ إبراهيم
طه حسين .. وحافظ إبراهيم

بقلم : د. وحيد عبدالمجيد
«أعجمى كاد يعلو نجمه – فى سماء الشعر نجم العربى – صافح العلياء فيها والتقى – بالمعرى فوق هام الشهب». هكذا مدح شاعر النيل حافظ إبراهيم نظيره الفرنسى فيكتور هوجو فى إحدى قصائده. ولا غرو فى ذلك، فهوجو شاعر فى الأساس قبل أن يكون روائيًا.
وهو معروف فى بلده بأنه شاعر أولاً ثم روائى ثانيًا. ولكنه اشتُهر فى أنحاء مختلفة فى العالم بأنه روائى فى المقام الأول. ويرجع ذلك إلى ترجمة أهم أعماله الروائية إلى لغات عدة فى الغرب كما فى الشرق، فاشتهرت على نطاق واسع، بخلاف دواوينه التى لم يُترجم منها إلا القليل الذى لم ينل مثل هذه الشهرة.
واللافت هنا أن شاعرًا كبيرًا مثل حافظ إبراهيم اختار أن يترجم له روايته الأكثر شهرة «البؤساء»، وليس ديوانًا من دواوينه الشعرية. وقد تعرضت هذه الترجمة لنقد شديد كان أشده وأكثره تفصيلاً من د. طه حسين فى الفصل الثامن من كتاب «حافظ وشوقي» الصادر فى عام 1933.
وانصب هذا النقد على لغة الترجمة التى وصفها حسين بأنها «بدوية جزلة لم تخلع أسمال البداوة، ولم ترتد حلل الحضارة» وأخذ عليه أن يصف بهذه اللغة عواطف ومعانى نشأت فى بيئة مختلفة تماماً فى أوروبا.
وأهم ما يأخذه حسين على الترجمة أنها غير مفهومة للعامة ولكثير من الخاصة, فقال إن «لغة الترجمة تحول بين القارئ وبين الفهم، لأنها لا تلائم روح العصر، ولا تعين على ما قصد إليه من نشر أدب هوجو». وأضاف: «لقد كلمت حافظ فى ذلك فقال: إنى عملت للخاصة، وكنت أظن أنى من هؤلاء الخاصة، فإذا بينى وبينهم أمد بعيد، وأحسب أن خاصة حافظ لا يوجدون إلا فى خياله».
ومع ذلك فقد أشاد بجهد شاعر النيل, فقال «إنى أحسب لحافظ هذه اللغة الجزلة، لأنها تدل على عناء وجهد عظيمين. وأنكرها عليه لأنها تكاد تجعل هذا الجهد غير نافع».
وهكذا يقدم عميد الأدب العربى نموذجًا رفيعًا للنقد البناء فى زمن كانت للحوار فيه قيمة كبيرة.
GMT 12:52 2026 السبت ,24 كانون الثاني / يناير
الحلُّ عندكمGMT 12:51 2026 السبت ,24 كانون الثاني / يناير
غرينلاند... نتوء الصراع الأميركي ــ الأوروبيGMT 11:29 2026 السبت ,24 كانون الثاني / يناير
عراقجي لزيلينسكي: لو غيرك قالها!GMT 11:27 2026 السبت ,24 كانون الثاني / يناير
المقاربة السعودية لليمن تكريس لفضيلة الاستقرارGMT 11:20 2026 السبت ,24 كانون الثاني / يناير
الأشْعَارُ المُحكَمَةُGMT 11:18 2026 السبت ,24 كانون الثاني / يناير
هل تُضعف أميركا نفسها؟GMT 11:17 2026 السبت ,24 كانون الثاني / يناير
النظام العالمي و«حلف القوى المتوسطة»GMT 11:15 2026 السبت ,24 كانون الثاني / يناير
مجلس الإمبراطور ترامبواشنطن تدعو الأوروبيين للتهدئة والاستماع لترامب بشأن غرينلاند
واشنطن ـ العرب اليوم
دعا وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت الأوروبيين إلى تفادي أي رد فعل "غاضب" والجلوس مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب في دافوس للاستماع إلى حججه بشأن ضم غرينلاند. وقال بيسنت للصحافيين قبل ساعات من وصول ترامب إلى ...المزيدتيك توك تطلق شركة تابعة في الولايات المتحدة لحماية خصوصية المستخدمين الأميركيين
واشنطن ـ العرب اليوم
أعلنت منصة "تيك توك" عن إنشاء شركة تابعة لها في الولايات المتحدة، مملوكة بأغلبية أسهمها لعدد من الشركات الأمريكية الكبرى، وذلك لحماية خصوصية المسخدمين الأمريكيين. وذكرت الشركة في بيان صحفي: "اليوم، وبموجب أ...المزيدملاحقات قضائية جديدة في إيران تشمل المثقفين والمقاهي على خلفية الاحتجاجات
طهران - العرب اليوم
فيما تتواصل الملاحقات القضائية بحق عدد من الموقوفين خلال الاحتجاجات التي عمت إيران خلال الفترة الماضية، أعلنت النيابة العامة فتح قضايا جديدة ضد شخصيات من عالمي الرياضة والثقافة. فقد أطلق مكتب المدعي العام في طهرا...المزيد Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2025 ©
Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2025 ©