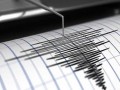الرئيسية
أخبارعاجلة
رياضة
- الأخبار الرياضية
- أخبار الرياضة
- فيديو أخبار الرياضة
- نجوم الملاعب
- أخبار الرياضة
- ملاعب عربية وعالمية
- بطولات
- أخبار الأندية العربية
- مقابلات
- رياضة عربية
- رياضة عالمية
- موجب
- سالب
- مباريات ونتائج
- كرة الطائرة
- كرة اليد
- كرة السلة
- رمي
- قفز
- الجري
- تنس
- سيارات
- غولف
- سباق الخيل
- مصارعة
- جمباز
- أخبار المنتخبات
- تحقيقات
- مدونات
- أخبار المحترفين
- غاليري
ثقافة
إقتصاد
فن وموسيقى
أزياء
صحة وتغذية
سياحة وسفر
ديكور
عناوين مشرقيّة لما بعد توقّف القتال في غزّة
عناوين مشرقيّة لما بعد توقّف القتال في غزّة

بقلم :حازم صاغية
لئن حفّ الغموض بالمراحل التالية لاتّفاقَ غزّة وتطبيقه فإنّ الوجهة العريضة المتاحة لمنطقة المشرق، كما ينمّ عنها الاتّفاق المذكور وسواه، لا يشوبها غموض.
فالواضح تماماً أنّ منظومة كاملة من القوى والأفكار تداعت غير مأسوف عليها، وهذا بعدما تولّت لعقود صياغة المنطقة وهندستها. لقد سقطت «المقاومة»، ليس فقط في ترجمتها العمليّة التي مثّلتها الميليشيا، ولكنْ أيضاً كنظام وطريقة في إملاء الحياة العامّة بوجهيها الداخليّ والخارجيّ، أي في علاقتيها بـ «أهلها» وبالعالم. كذلك سقطت «القضيّة» بوصفها المصادرة والتصنيع المزمنين لمأساة الفلسطينيّين، كما بوصفها «فيتّو» على إرادتهم وعلى سيادات الدول المجاورة سواء بسواء. وبدورها سقطت «الثورة الإسلاميّة» كمبدأ مفجّر للمجتمعات وللدول، وكنموذج مانع للتقدّم وعائق يصدّ الحداثة عن بلدها وعن المنطقة. وفي الحسابات الاستراتيجيّة سقط حلف الممانعة الذي انهار بعض أنظمته فيما يترنّح بعضها الآخر، وتالياً سقط مبدأ الاعتماد على أخ أكبر قويّ ومرهوب الجانب يحتمي به خُدّامه الصغار.
وباستثناء نظام الأسد، يجمع الإسلام السياسيّ، بالسنّيّ منه والشيعيّ، بين أطراف التداعي تلك. وهذا ما يجيز المقارنة بالضربة التي ألمّت بالقوميّة العربيّة العسكريّة، بالناصريّ منها والبعثيّ، في هزيمة 1967، بعدما كانت، على امتداد عقد ونيّف، الطرف الذي يملي على المنطقة توجّهاتها.
وهذا بمثابة انحسار لعالم بكامله من القوى والعلاقات يضع المشرق العربيّ راهناً أمام فراغ يلحّ على إعادة تأسيس نفسه في ظلّ افتقار إلى أدوات هذه المهمّة. فلئن رُفع خيار الإسلام السياسيّ لملء الفراغ الذي خلّفته القوميّة العربيّة وأنظمتها بعد 1967، فما الذي سيُرشَّح لملء الفراغ الذي ينجم عن ضمور الإسلام السياسيّ ذاته؟
والقلقَ، هنا، تثيره وتضاعفه أحوال العلاقات الأهليّة، الدينيّة والطائفيّة والإثنيّة، في أصقاع المنطقة، بما فيها غزّة، حيث قد تبادر الجماعات إلى ملء ذاك الفراغ عنفيّاً وعبر منازعات بينيّة. وقلق كهذا يستند إلى أسباب موضوعيّة يتصدّرها أنّ التوافقات والائتلافات التي كانت قائمة، في مواجهة قوى المحور الممانع، سقطت كلّها، بالمعلن منها والضمنيّ. وكثيراً ما تلازم هذا السقوط مع صعود في الريبة والعداء بين حلفاء الأمس اللبنانيّين والسوريّين.
ويندرج التطوّر هذا في انشطار الجماعات «الوطنيّة» وتذرّرها بعد تاريخ مديد من كبت الأسئلة التي كان ينبغي أن تُسأل وتُناقَش ويُجاب عنها مع نيل الاستقلالات. وهكذا يلوح كما لو أنّ أبناء المنطقة الممتدّة من فلسطين إلى العراق لا يعرفون إلى أيّ غد سوف يتّجه بهم يومهم، وما طبيعة الأوطان التي ستحتويهم وما شكلها. وهذا فيما الإحباطات المتولّدة عن الهزيمة والمهانة والشكوك العميقة بكلّ شيء تقريباً لا تفعل سوى تقوية مصادر التناحر الداخليّ، وهي قويّة أصلاً بما يكفي.
فالسابع من أكتوبر وتوابعه لم تكن ضربات عسكريّة فحسب، إذ يتأدّى عنها طرح أسئلة وجوديّة على المشرقيّين، لا على الفلسطينيّين وحدهم، من صنف: من نحن؟ وعلى ماذا يقوم تعاقدنا؟ وإلى أين نتّجه؟ فعلى ما يبدو لن تكون نجاة أيّ «نوح» أمراً سهلاً في هذا «الطوفان».
وللأسف فبسبب من عطالة متأصّلة في ثقافة المشرق السياسيّة المعمّمة، وتبعاً لعجز متراكم عن ممارسة التغيير الذاتيّ، تُركت هذه المهمّة لإسرائيل. هكذا تولّت الأخيرة إنجازها بثأريّة إباديّة مكّنتها من أن تبني حول نفسها نطاقاً استراتيجيّاً إمبراطوريّاً يوفّر لها الأمن ويلزم الجميع بالتعامل معه كمعطى راسخ يصعب التكهّن بمدى ديمومته الزمنيّة.
وإذا كان ثمّة مَن يطمئنه هذا التطوّر إذ يكرّس نزع الصراع، الذي انبثقت منه «القضيّة» القاتلة، ويشقّ طريقاً إلى سلام واستقرار إقليميّين، فإنّ آخرين يساورهم الخوف، وهو وجيه، من أن يصبّ التطوّرُ المذكور زيتاً كثيراً على نار التنازع الداخليّ بحيث تستثمره، بجلافتها وثأريّتها المعهودتين، فئات أهليّة ضدّ فئات أخرى. وإذا تسنّى لبنيامين نتانياهو وائتلافه الحكوميّ البقاء في السلطة وجد افتراض كهذا مزيداً من الحجج والمدد.
يكمّل رسمَ اللوحة الداكنة تلك ثقافةٌ كاذبة لا تتوقّف عن الإنكار إلاّ لتعلن الانتصار، معزّزةً تلبّدَ الرؤية بقدر معتبر من الضباب. وهذه إنّما تشنّ كلّ لحظة 7 أكتوبر سياسيّة وإعلاميّة تكمّل بها 7 أكتوبر الحربيّة، سحقاً للعقل والحقيقة من جهة، ورفعاً لمسؤوليّة صانعي الكارثة عنهم من جهة أخرى.
بيد أنّ أمراً واحداً، لم يحظ بالاهتمام الذي يستحقّه، ينطوي على شيء مضيء. ذاك أنّ الحجّة الأكثر تكراراً في الدفاع عن «خطّة ترمب» لغزّة دارت حول وقف الموت فوراً، علماً بأنّ كثيرين ردّدوا هذه العبارة رفعاً للعتب أو ستراً للهزيمة. ونعرف أنّ بناء خلاصات سياسيّة على مقدّمات كهذه ليس من شيم الثقافة السياسيّة السائدة في منطقتنا، إذ عملاً برقم «المليون شهيد»، باتت حركاتنا الفاعلة تكافح كي تكون «مَن يربح المليون».
فهل يُكتب النماء والتطوّر لهذه الطريقة المغايرة في النظر إلى الأشياء وإلى العالم، ما قد يؤنسن ثقافة ضالعة في الموت والإماتة؟
GMT 02:05 2025 الأحد ,12 تشرين الأول / أكتوبر
كتاباته قتلتهGMT 02:03 2025 الأحد ,12 تشرين الأول / أكتوبر
موسى أبو مرزوق يرد عليهم!GMT 02:00 2025 الأحد ,12 تشرين الأول / أكتوبر
قِسْ على «نوبل» غيرهاGMT 01:54 2025 الأحد ,12 تشرين الأول / أكتوبر
غزة وشرم الشيخ... نهاية الحرب وبداية حل الدولتينGMT 01:50 2025 الأحد ,12 تشرين الأول / أكتوبر
انتهينا من «نوبل»... فماذا عن فلسطين والمنطقة؟GMT 01:48 2025 الأحد ,12 تشرين الأول / أكتوبر
فرنسا ومأزق تجميد العملية السياسيةGMT 01:44 2025 الأحد ,12 تشرين الأول / أكتوبر
الخروج من معطف مورافياGMT 01:42 2025 الأحد ,12 تشرين الأول / أكتوبر
ما بعد وقف الحربحاكم المصرف المركزي السوري يعلن إصدار عملة جديدة تضم ست فئات دون صور أو رموز تقليدية
دمشق ـ العرب اليوم
كشف حاكم مصرف سوريا المركزي، عبد القادر الحصرية، أن العملة السورية الجديدة ستصدر بـ6 فئات مختلفة، وستكون خالية من الصور والرموز التقليدية، لتتميز بالوضوح وسهولة التحقق، بما يتماشى مع الاتجاه العالمي نحو التصميم ا...المزيدغادة عادل تكشف تفاصيل تجربتها السينمائية الجديدة وتؤكد أنه فيلم مختلف
القاهره - العرب اليوم
عادت الفنانة المصرية غادة عادل إلى شاشة السينما من خلال فيلمها الجديد "فيها إيه يعني؟"، الذي يُعرض حاليًا في دور العرض، ويجمعها بالنجم ماجد الكدواني في عمل يُعيد إلى الواجهة نمط الأفلام الرومانسية ذات الطابع �...المزيداستقالة مهندس برمجيات من مايكروسوفت بسبب موقفه من ما يجري في غزة
واشنطن ـ العرب اليوم
قدم مهندس البرمجيات في شركة «مايكروسوفت» سكوت سوتفين جلوسكي استقالته، وذلك احتجاجاً على استمرارها في تقديم خدماتها للجيش الإسرائيلي، وكذلك لرفض المديرين التنفيذيين مناقشة مخاوف العاملين بشأن الحرب في غزة.و...المزيدالكاتب المجري كراسنهوركاي يفوز بجائزة نوبل للآداب عن أدب "رؤيوي في زمن الرعب"
ستوكهولم - العرب اليوم
أعلنت الأكاديمية السويدية منح جائزة نوبل في الأدب لعام 2025 للكاتب المجري لازلو كراسنهوركاي، تكريمًا لـ"منجزه الأدبي الآسر والرؤيوي الذي يؤكد، في خضمّ رعبٍ ينذر بنهاية العالم، قوّة الفن"، في لحظةٍ طال انتظارها...المزيد Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2025 ©
Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2025 ©