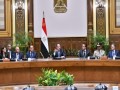الرئيسية
أخبارعاجلة
رياضة
- الأخبار الرياضية
- أخبار الرياضة
- فيديو أخبار الرياضة
- نجوم الملاعب
- أخبار الرياضة
- ملاعب عربية وعالمية
- بطولات
- أخبار الأندية العربية
- مقابلات
- رياضة عربية
- رياضة عالمية
- موجب
- سالب
- مباريات ونتائج
- كرة الطائرة
- كرة اليد
- كرة السلة
- رمي
- قفز
- الجري
- تنس
- سيارات
- غولف
- سباق الخيل
- مصارعة
- جمباز
- أخبار المنتخبات
- تحقيقات
- مدونات
- أخبار المحترفين
- غاليري
ثقافة
إقتصاد
فن وموسيقى
أزياء
صحة وتغذية
سياحة وسفر
ديكور
ساعة «فلسطين الدولة»
ساعة «فلسطين الدولة»

بقلم : فؤاد مطر
سجلت القمتان «العربية - الإسلامية» الاستثنائية والقمة الخليجية، اللتان انعقدتا في المكان واليوم نفسيهما بالدوحة عاصمة قطَر، وقفة الأخ مع أخيه الذي أصيب بمكروه عدواني، تنوَّع توصيف بعض القادة المشاركين له بأنه «غادر، وماكر، وسافر»، وذهب بعض القادة إلى القول «إن ما تفعله إسرائيل يقوِّض القانون الدولي». إلّا أنَّ هذه التوصيفات بقيت ضِمن أصول التعامل بمسؤولية لجهة التلفظ، ولجهة صياغة القرارات.
ورغم فوران الشعور بالغضب لدى بعض القادة المشاركين في القمة بوصفه نوعاً من مشاركة قَطر صدمة واقعة العدوان عليها سيادة ودوراً يستهدف تفكيك العُقد المستعصية في التسوية المأمولة للمحنة الغزاوية، وإرفاق ذلك بالدعوة إلى رفْع مستوى التنسيق العسكري، فإنَّ جوهر النوايا كان يروم المزيد من السعي لدى الدول الكبرى؛ وبالذات الدول الحاضنة إسرائيل منذ إعلان اعتراف الرئيس هاري ترومان بالدولة المحتلة ومسايرة الرئيس دونالد ترمب للحُكم الإسرائيلي، وإلى درجة قبول اعترافات نتنياهو العدوانية المستمرة، للمساعدة في إفساح مجال الأخذ بصيغة التسوية حقاً وأرضاً لكلا الشعبين الفلسطيني العربي بجناحيْه الإسلامي والمسيحي، وكذلك للشعب اليهودي الذي استوطن دون وجه حق فلسطين. وهذه الصيغة ما كانت لتأخذ طريقها واثقة الخطى إلى الأمم المتحدة، والتصويت المبهر على الاعتراف بـ«الدولة الفلسطينية»، لولا السعي الذي قام به بعقلية المستنير ورجل الدولة المتبصر الثنائي ولي العهد السعودي رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، ورئيس الجمهورية الفرنسية إيمانويل ماكرون.
كان هنالك تصوُّر بأنه ما دامت القمة العربية - الإسلامية استثنائية، وفي ضوء عدوان استهدف دولة لا تناصب إسرائيل عداوة مَن هي احتُلت أرضه على نحو ما هي عليه الحال مع كل من لبنان وسوريا التي ليست فقط تحتل أرضاً فيهما، وإنما تعتدي حيث تشاء، فإن الوقوف ضد مشروع نتنياهو «إسرائيل الكبرى» واجب المواجهة.
وما حفلت به القمة العربية - الإسلامية، ثم قمة دول مجلس التعاون الخليجي في قَطر يوميْ 15 و16 سبتمبر (أيلول) 2025، من مشاورات وقرارات وتصريحات غير صارخة، لم تكن فقط مجرد وقفة نخوية مع دولة شقيقة اعتُدي على سيادتها وصفاء نواياها، وعلى سعيها من أجْل التوصل مع الدولة الكبرى مصر والسند السعودي المؤثر إقليمياً ودولياً، إلى إيجاد حل أكثر تقدماً من ذي قبْل للصراع العربي - الإسرائيلي، وإنما فِعْل رؤية اكتسبت صلابة بثنائية التوافُق النسبي حول ذلك، وهو توافُق ما كان ليتحقق قبْل التجاوب المتدرج من جانب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، مع ما سعى إليه ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، وبذلك بدا المشهد يكتسب ملامح انسجام مع السعي العربي الموضوعي لترويض متدرج للصراع. وهذا بدا ملموساً في القمم السعودية - الإسلامية - الخليجية - الأميركية في الرياض، وما سبقها، وكذلك ما تلاها من قمم سعودية - صينية، وسعودية - روسية، وسعودية - فرنسية، وهي قمم كانت الدبلوماسية السعودية تنشط لإبقاء ما جرى التوافق في شأنه بالنسبة للصراع العربي - الإسرائيلي حاضراً في «الأجندة» الدولية، ثم يأتي قطاف تلك القمم والمساعي المتواصلة وبعيداً عن التصريحات بمفردات شعبوية، متمثلاً في التصويت الإيجابي بالأمم المتحدة على الاعتراف بضرورة قيام دولة فلسطينية. وليس مستبعَداً أن يكون هذا المردود العملي والهادئ هو الذي دفع بالتوجه البنياميني إلى مواصلة إشعال الأرض الغزاوية ناراً وتجويعاً وتهجيراً، ويبلغ بنتنياهو الإحساس بأنَّ ورقة «إسرائيل الكبرى» مرشحة للتطاير أمام هذا التوجه العربي اللافت نحو التمسك بالسلام.
يبقى القول إن ما حصل من تكاتف وتوافق، أعطى دفعة قوية للنهج الذي يستهدف إحلال السلام، بدل الاحتراب والانقسام والعداوات على أنواعها. ولقد افترض البعض قبْل أن تبدأ القمتان في الدوحة التشاور في الانتقال من ضفاف التسويات السلمية إلى ما هو أكثر من التحديات اللفظية، ما دامت إسرائيل مصرة على امتهان العدوان غير عابئة بالقوانين والاتفاقيات والتعاهدات، أن ما سيصدر عن القمة من قرارات هو أشد عزماً وحزماً من تلك التي تم إصدارها. ولكن ثمة حالة غير محسومة؛ وهي أن عدم الأخذ بخيار المواجهة هو ورقة برسم الإدارة الأميركية التي باتت، وإن هي لم تعلن ذلك على الملأ، كثيرة الانزعاج من السلوك الإسرائيلي؛ وهو سلوك لا بد أن ينحسر عندما تتخذ هذه الإدارة موقفاً في ضوء وقفات تؤكد لدى قادة الأمتين، ومعهم الشعوب ومجتمعات أممية كثيرة، أن ما تقوم به إسرائيل منذ ثلاث سنوات من اعتداءات، لن يحقق للتطلعات الإسرائيلية مبتغاها، وأن الموقف من الإدارة الأميركية يتجاوز العتب بكثير.
وبهذا يكون مضمون القمتين في الدوحة لجهة النُّصح المستديم والتحذير المستجد، هو السعي إلى حين قيام «فلسطين الدولة».
GMT 09:58 2026 الخميس ,05 آذار/ مارس
ولا ولنGMT 09:56 2026 الخميس ,05 آذار/ مارس
بماذا ولماذا ستنصر روسيا والصين إيران؟!GMT 09:54 2026 الخميس ,05 آذار/ مارس
الحرب والنفط والاضطراب؟GMT 09:52 2026 الخميس ,05 آذار/ مارس
أين أخطأت إيران؟GMT 09:50 2026 الخميس ,05 آذار/ مارس
هل علينا أن نخاف من التقنية؟!GMT 09:41 2026 الخميس ,05 آذار/ مارس
السيد «كا عبر» شيخ البلدGMT 09:39 2026 الخميس ,05 آذار/ مارس
البحث عن «معنى» أو «غنيمة»GMT 09:36 2026 الخميس ,05 آذار/ مارس
«سكوكروفت» للاستراتيجية ورؤية للعالم 2036بوتين يلوح بإمكانية وقف توريد الغاز الروسي للأسواق الأوروبية فورًا
موسكو - العرب اليوم
لمح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء، إلى إمكانية توقف روسيا عن توريد الغاز إلى الأسواق الأوروبية في الوقت الحالي والتوجه نحو أسواق أكثر جدوى. وأفاد مسؤولون في الاتحاد الأوروبي ووثيقة اطلعت عليها &...المزيدمنافسة باردة بين محمد سامي وعمرو سعد بعد نجاح مسلسل الست موناليزا
القاهرة ـ العرب اليوم
يشهد سباق الدراما الرمضاني منافسة من نوع آخر، وحربا باردة بين المخرج محمد سامي والفنان عمرو سعد، بسبب التنافس على لقب الأعلى مشاهدة في رمضان. محمد سامي الذي يغيب عن الموسم هذا العام، تتواجد زوجته الفنانة مي عمر، من...المزيدميتا تخفف قيودها على روبوتات الدردشة في واتساب
واشنطن ـ العرب اليوم
في محاولة لتفادي فتح تحقيق واسع من قبل المفوضية الأوروبية، أعلنت شركة “ميتا”، أنها ستسمح لشركات الذكاء الاصطناعي بتقديم روبوتات الدردشة الخاصة بها عبر تطبيق واتساب باستخدام الواجهة الخاصة بتطبيق واتساب WhatsAp...المزيداستقالة مديرة متحف اللوفر على خلفية حادثة سرقة جواهر التاج البريطاني
باريس ـ العرب اليوم
استقالت مديرة متحف اللوفر الشهير في باريس، الثلاثاء، على خلفية سرقة جواهر التاج البريطاني التي بلغت قيمتها 88 مليون يورو (100 مليون دولار) العام الماضي، والتي وُصفت بأنها "سرقة القرن". وأعلن الرئيس الفرنسي إي...المزيد Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2025 ©
Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2025 ©