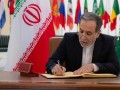الرئيسية
أخبارعاجلة
رياضة
- الأخبار الرياضية
- أخبار الرياضة
- فيديو أخبار الرياضة
- نجوم الملاعب
- أخبار الرياضة
- ملاعب عربية وعالمية
- بطولات
- أخبار الأندية العربية
- مقابلات
- رياضة عربية
- رياضة عالمية
- موجب
- سالب
- مباريات ونتائج
- كرة الطائرة
- كرة اليد
- كرة السلة
- رمي
- قفز
- الجري
- تنس
- سيارات
- غولف
- سباق الخيل
- مصارعة
- جمباز
- أخبار المنتخبات
- تحقيقات
- مدونات
- أخبار المحترفين
- غاليري
ثقافة
إقتصاد
فن وموسيقى
أزياء
صحة وتغذية
سياحة وسفر
ديكور
الشرير لا يولد شريرًا
الشرير لا يولد شريرًا

بقلم : د. وحيد عبدالمجيد
تطرق الحديث فى جلسة أصدقاء إلى دور السينما فى التعريف بروايات ما كان لها أن تحظى بالاهتمام الذى نالته ما لم تتحول إلى أفلام سينمائية. ومن بين ما نوقش سؤال عما إذا كانت السينما تخدم الرواية التى تتحول إلى فيلم أم تظلمها حين تطغى عليها فينساها الناس مع الوقت ولا يذكرون إلا العمل السينمائى المبنى عليها أو المقتبس منها. لم يصل النقاش إلى اتفاق إذ انقسم المتناقشون فى إجاباتهم عن ذلك السؤال، إذ رأى بعضهم أن السينما تخدم الرواية، بينما ذهب آخرون إلى أنها تظلمها. ومع ذلك كان هناك ما يشبه الاتفاق على أن الأفلام التى تحمل أسماء الروايات كما هى دون تغيير أو تبديل فيها تخدم الرواية أكثر مما تظلمها، إذ تجعل اسم هذه الرواية أو تلك معروفًا أو شائعًا على نطاق واسع، الأمر الذى قد يدفع بعض من شاهدوا الفيلم إلى الإطلاع على الرواية المأخوذ منها.
وربما تكون الأفلام المقتبسة من ثلاثية نجيب محفوظ (بين القصرين وقصر الشوق والسكرية) الأكثر شهرة ودلالة على هذا النوع من العلاقة بين السينما والرواية. ولكنها ليست وحدها. فقد جال فى خاطرى خلال تلك المناقشة رواية فتحى غانم "الرجل الذى فقد ظله" الصادرة عام 1961، والتى اقتُبس منها فيلم حمل اسمها نفسه وعُرض للمرة الأولى عام 1986. وهى رواية رائعة ليس فقط من حيث بنائها الفنى وأسلوبها، بل من زاوية رسالتها أيضًا. تُحكى فى الرواية حكاية صعود شخص صار كبيرًا وانتقل من قاع المدينة إلى قمتها وأضوائها ونجوميتها، لأنه برع فى انتهاز الفرص. ويحكى غانم هذه الحكاية أربع مرات بلسان ثلاث شخصيات أسهمت فى صعود هذا الشخص ثم بلسانه هو، فى بناء فنى مبدع وجميل لا يمكن اكتشافه عبر مشاهدة الفيلم دون العودة إلى الرواية. ولكن ما يجوز استلهامه من الفيلم والرواية معًا هو الرسالة التى تفيد أن الشرير لا يولد شريرًا، بل يصبح كذلك بفعل ظروف تؤثر فى تكوينه وشخصيته.
وتستحق قضية العلاقة بين السينما والرواية أن نبقى معها غدًا.
GMT 12:01 2025 الخميس ,06 تشرين الثاني / نوفمبر
صدقوني إنها «الكاريزما»!GMT 11:53 2025 الخميس ,06 تشرين الثاني / نوفمبر
إحياء الآمال المغاربيةGMT 11:50 2025 الأربعاء ,05 تشرين الثاني / نوفمبر
النار في ثياب ترامبGMT 11:40 2025 الخميس ,06 تشرين الثاني / نوفمبر
.. وفاز ممدانيGMT 11:07 2025 الخميس ,06 تشرين الثاني / نوفمبر
التاريخ والجغرافيا والمحتوىGMT 10:59 2025 الخميس ,06 تشرين الثاني / نوفمبر
مرة أخرى.. قوة دولية فى غزة !GMT 10:56 2025 الخميس ,06 تشرين الثاني / نوفمبر
حلم المساواةGMT 10:24 2025 الخميس ,06 تشرين الثاني / نوفمبر
عرفان وتقديرالصين تعلّق جزءاً من الرسوم الجمركية على السلع الأميركية وسط توتر تجاري مستمر مع واشنطن
بكين - العرب اليوم
أعلنت الصين، الأربعاء، تعليق الرسوم الجمركية الإضافية البالغة 24% على السلع الأميركية لمدة عام واحد، مع الاحتفاظ برسوم بنسبة 10% على هذه السلع، في خطوة تهدف إلى التخفيف من حدة التوترات التجارية مع الولايات المتحدة. ك...المزيدأحمد حلمي وهند صبري يلتقيان في فيلم جديد للمخرج عمر هلال بعنوان "أضعف خَلقه"
القاهرة ـ العرب اليوم
أعلن المخرج المصري عمر هلال عن مشروعه السينمائي الجديد بعنوان "أضعف خَلقه"، الذي يجمع لأول مرة بين النجمين أحمد حلمي وهند صبري في تجربة فنية ينتظرها جمهور السينما المصرية بشغف. ويأتي هذا الفيلم بعد النجاح الكب...المزيدإيلون ماسك يطلق ميزة جديدة في غروك لتحليل منشورات منصة إكس
واشنطن - العرب اليوم
كشف الملياردير الأميركي إيلون ماسك عن ميزة رائعة بات "غروك"، مساعد الذكاء الاصطناعي المطور من شركة "إكس إيه آي" الناشئة، يقدمها إلى الملايين من مستخدمي منصة "إكس" حول العالم. فقد أعلن ماسك، في فيديو ن...المزيد Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2025 ©
Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2025 ©