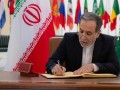الرئيسية
أخبارعاجلة
رياضة
- الأخبار الرياضية
- أخبار الرياضة
- فيديو أخبار الرياضة
- نجوم الملاعب
- أخبار الرياضة
- ملاعب عربية وعالمية
- بطولات
- أخبار الأندية العربية
- مقابلات
- رياضة عربية
- رياضة عالمية
- موجب
- سالب
- مباريات ونتائج
- كرة الطائرة
- كرة اليد
- كرة السلة
- رمي
- قفز
- الجري
- تنس
- سيارات
- غولف
- سباق الخيل
- مصارعة
- جمباز
- أخبار المنتخبات
- تحقيقات
- مدونات
- أخبار المحترفين
- غاليري
ثقافة
إقتصاد
فن وموسيقى
أزياء
صحة وتغذية
سياحة وسفر
ديكور
«مجلس ترامب».. أى مستقبل ينتظره؟!
«مجلس ترامب».. أى مستقبل ينتظره؟!

بقلم : عبد الله السناوي
داهمت التحديات الصعبة «مجلس السلام»، أو بالأحرى «مجلس ترامب»، فى لحظة التوقيع على وثيقته التأسيسية.
فكرته تتمحور حول شخصية ورؤى وتصورات، أو نزوات وأهواء الرئيس الأمريكى؛ فهو وحده الذى يقترح ويوجه، ويملك حق التعيين والعزل فى مؤسساته المفترضة.
يعرف «مجلس السلام» نفسه بأنه: «هيئة دولية يترأسها الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، وهو يعنى بإعادة إعمار غزة وتعزيز السلام الدائم فى مناطق النزاع».
صلاحياته تجاوزت فكرته الرئيسية، قبل أن تُختبر فى غزة المحاصرة والجائعة، أو أن تؤكد قدرتها على مواجهة تعقيدات الصراع العربى الإسرائيلى، التى يصعب حلها بقفزات فى الهواء تضفى عليها صفات العظمة المسبقة، أو القدرة على حل الأزمات التى فشلت فيها الأمم المتحدة، لمجرد أن «ترامب» يترأسها!
فى نقده المتواصل للمنظمة الدولية نعتها بأنها «منظمة بيروقراطية، لم تفعل شيئًا مما استطاع هو أن ينجزه فى سنته الأولى من رئاسته الثانية!».
لم يطرح على نفسه هذا السؤال: لماذا فشلت المنظمة الدولية؟ وما مسئولية الولايات المتحدة عن هذا الفشل؟
على مدى عقود عطّلت واشنطن بحق النقض استصدار أى قرار أممى إذا ما تصادم مع مصالحها وانحيازاتها، بغض النظر عن طبيعة القضية، سواء كانت مشروعة أو غير مشروعة.
كانت القضية الفلسطينية الضحية الأولى للسياسات الأمريكية، لكنها لم تكن الوحيدة.
تأسست فكرة «مجلس السلام» على نوع من القفز إلى المجهول، تعويلًا على الأهواء، وفى غياب شبه مطلق لأى احترام للقانون الدولى.
الأفدح أن الحلفاء الكبار التقليديين للولايات المتحدة فى الغرب تحفظوا على الفكرة كلها، أو رفضوها علنًا على خلفية أزمة ««جزيرة جرينلاند» الدنماركية.
يشترط أى بديل للأمم المتحدة، المتهاوية فعلًا، إجماعًا دوليًا واسعًا، أو أغلبية مؤثرة ووازنة، وهو ما غاب بفداحة عن الاجتماع التأسيسى، وعدَّ بذاته نوعًا من الإخفاق المبكر.
فى المشهد الافتتاحى تبدت أزمتان كبيرتان كاختبارين حاسمين لـ«مجلس ترامب».
الأزمة الأولى، الحرب على غزة، التى استدعت الفكرة نفسها، قبل أن يضعها الرئيس الأمريكى على محك نظام دولى جديد تتحكم فيه الإرادة المنفردة للقوة الأمريكية العظمى.
فى نص الوثيقة التأسيسية غاب أى ذكر للقضية الفلسطينية، ولم تجرِ أية إشارة إلى غزة، أو إلى أى دور محتمل للسلطة فى رام الله.
فى مداخلة غير مكتوبة أشار «ترامب» عابرًا إلى ساحل غزة الساحر.
لم تكن تلك زلة لسان بقدر ما كانت تعبيرًا عما ينتويه فعلًا، متذرعًا هذه المرة باسم «مجلس السلام»!
هذه عودة مضمرة، لكنها واضحة، إلى مشروع «ريفييرا غزة»، الذى استدعى، عندما طُرح للمرة الأولى، غضبًا واسعًا خشية التهجير القسرى من غزة إلى سيناء المصرية، وتفريغ القضية الفلسطينية من طبيعتها كقضية تحرر وطنى.
غاب عن الوثيقة التأسيسية أى ذكر لحق الفلسطينيين فى تقرير مصيرهم، ولا أى استعداد للاعتراف بالدولة الفلسطينية.
بالمقابل كان حاسمًا فى تبنى المطالب الإسرائيلية، خاصة أولوية نزع سلاح «حماس» واستعادة رفات آخر جندى إسرائيلى.
يلفت الانتباه أن قوة الاستقرار الدولية تبدو متعذرة الآن.
لا أحد فى العالم كله مستعد أن يحارب «حماس» بالنيابة عن إسرائيل.
سكت «ترامب» تمامًا عن أية إشارة للخروقات الإسرائيلية اليومية لوقف إطلاق النار فى غزة، فيما توسع كليًا فى تهديد «حماس» بالسحق إذا لم تقم بنزع سلاحها من تلقاء نفسها.
وبدرجة مماثلة لوّح بسحق إيران إذا ما حاولت استعادة مشروعها النووى، لكنه أعرب فى الوقت نفسه عن استعداده للتفاوض معها.
رغم ذلك كله غابت إسرائيل عن أى تمثيل فى الاجتماع التأسيسى، كنوع من الضغط الإضافى قبل أن يبدأ مجلس «ترامب» أعماله.
وبصياغة أخرى، أرادت ضبط قواعد العمل حسب أجندة الحكومة اليمينية المتطرفة فى إسرائيل.
وفق نفس الاستراتيجية نفسها اعترضت أن يضم تشكيل المجلس تركيا وقطر، لكنها وافقت عمليًا، بتفاهمات كواليس مع المبعوث الرئاسى الأمريكى «ستيف ويتكوف» وصهر الرئيس «جاريد كوشنر»، سوف تتبدى فى وقت تالٍ ثمنًا لما تراه تنازلًا كبيرًا!
هكذا عارضت إعادة فتح معبر رفح من الجانبين المصرى والفلسطينى للحصول على ثمن سياسى إضافى.
أمام الابتزازات الإسرائيلية المنهجية، معضلة «ترامب» أنه لا يرغب فى أى صدام كبير معها، ولا يريد فى الوقت نفسه أن يبدو ضعيفًا.
الأزمة الثانية، مصير جزيرة جرينلاند، التى خيمت بظلالها الاستراتيجية على الاجتماع التأسيسى.
عبرت الأزمة، بحمولاتها السياسية والاستراتيجية، عن أخطر تصدع فى التحالف الغربى قد يصل إلى تفكيك حلف «الناتو» والتقويض النهائى للنظام الدولى.
استبعد «ترامب» أى عمل عسكرى، دون أن يتراجع عن صلب أهدافه فى الاستيلاء على الجزيرة الاستراتيجية القطبية الغنية بالمعادن النفيسة.
تبدت فى دافوس إشارات إلى تسوية محتملة قادها أمين عام حلف «الناتو»، دون تفويض مسبق من الدنمارك أو حكومة الجزيرة، التى أعلنت أنها لم تفوض أحدًا للتحدث باسمها.
بضغوطه المخالفة للقانون الدولى وأبسط قواعد الشراكة مع الحلفاء، ربما ينجح «ترامب» فى تحقيق أغلب مطالبه بأزمة جرينلاند، غير أن شرخًا عميقًا يصعب ترميمه أصاب العلاقة بين ضفتى الأطلسى.
هكذا تبدو أطلال النظام الدولى أكثر انكشافًا واضطرابًا، دون أن يكون ممكنًا لما يُطلق عليه «مجلس السلام» أن يحقق أهدافه ومراميه!
GMT 05:08 2026 الإثنين ,26 كانون الثاني / يناير
سرُّ حياتهمGMT 05:07 2026 الإثنين ,26 كانون الثاني / يناير
رفعت الأسد… أحد رموز الدولة المتوحّشةGMT 05:05 2026 الإثنين ,26 كانون الثاني / يناير
الإصلاح المستحيل: لماذا لا يملك خامنئي منح واشنطن ما تريد؟GMT 05:01 2026 الإثنين ,26 كانون الثاني / يناير
وأخيرا استجابت الهيئة..لا للأحزاب الدينيةGMT 04:59 2026 الإثنين ,26 كانون الثاني / يناير
المباراة المثاليةGMT 04:56 2026 الإثنين ,26 كانون الثاني / يناير
كرة الثلج الأسترالية والسوشيال ميدياGMT 04:55 2026 الإثنين ,26 كانون الثاني / يناير
المعاون الأنيس للسيد الرئيسGMT 04:54 2026 الإثنين ,26 كانون الثاني / يناير
أزمة غرينلاند وتفريغ السيادةالذهب يتجاوز 5000 دولار للأونصة ويواصل صعوده التاريخي وسط موجة من القلق العالمي
واشنطن ـ العرب اليوم
وصل سعر الذهب إلى مستوى قياسي جديد، متجاوزاً 5000 دولار للأونصة يوم الاثنين، مواصلاً بذلك صعوداً تاريخياً مع إقبال المستثمرين على هذا الأصل كملاذ آمن وسط تصاعد حالة عدم اليقين الجيوسياسي. وارتفع سعر الذهب الفوري بن�...المزيددنيا بطمة تكشف كواليس وأصعب اللحظات في فترة سجنها وتستعرض قوتها وشخصيتها الإيجابية
الرباط ـ العرب اليوم
دنيا بطمة، المطربة المغربية، عادت إلى الظهور الإعلامي بعد فترة من انتهاء أزمة سجنها وعودتها إلى الحياة الطبيعية، وفتحت دنيا بطمة قلبها للجمهور في لقائها مع قناة "المشهد"، وتحدثت عن كواليس وأسرار فترة سجنها وأ...المزيدتيك توك تطلق شركة تابعة في الولايات المتحدة لحماية خصوصية المستخدمين الأميركيين
واشنطن ـ العرب اليوم
أعلنت منصة "تيك توك" عن إنشاء شركة تابعة لها في الولايات المتحدة، مملوكة بأغلبية أسهمها لعدد من الشركات الأمريكية الكبرى، وذلك لحماية خصوصية المسخدمين الأمريكيين. وذكرت الشركة في بيان صحفي: "اليوم، وبموجب أ...المزيدملاحقات قضائية جديدة في إيران تشمل المثقفين والمقاهي على خلفية الاحتجاجات
طهران - العرب اليوم
فيما تتواصل الملاحقات القضائية بحق عدد من الموقوفين خلال الاحتجاجات التي عمت إيران خلال الفترة الماضية، أعلنت النيابة العامة فتح قضايا جديدة ضد شخصيات من عالمي الرياضة والثقافة. فقد أطلق مكتب المدعي العام في طهرا...المزيد Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2025 ©
Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2025 ©