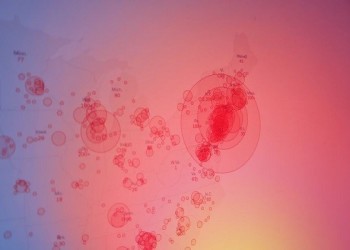الرئيسية
أخبارعاجلة
رياضة
- الأخبار الرياضية
- أخبار الرياضة
- فيديو أخبار الرياضة
- نجوم الملاعب
- أخبار الرياضة
- ملاعب عربية وعالمية
- بطولات
- أخبار الأندية العربية
- مقابلات
- رياضة عربية
- رياضة عالمية
- موجب
- سالب
- مباريات ونتائج
- كرة الطائرة
- كرة اليد
- كرة السلة
- رمي
- قفز
- الجري
- تنس
- سيارات
- غولف
- سباق الخيل
- مصارعة
- جمباز
- أخبار المنتخبات
- تحقيقات
- مدونات
- أخبار المحترفين
- غاليري
ثقافة
إقتصاد
فن وموسيقى
أزياء
صحة وتغذية
سياحة وسفر
ديكور
مع «بوستمان» التكنولوجيا والتسلية
مع «بوستمان» التكنولوجيا والتسلية

بقلم : فهد سليمان الشقيران
لو قُدّر لفلاسفةٍ مثل جيل دلوز أو بيار بورديو، وغيرهما من الفلاسفة الذين انشغلوا بصدمة ظهور التلفزيون قبل عقود من الآن أن يعيشوا عوالم التكنولوجيا التي تتفجّر في وقتنا الحالي، ماذا عساهم سيقولون إذاً؟! من شبه المؤكد تقريباً أنهم ربما سيصابون بالذهول.
الاكتشافات التي تحدث عنها الفلاسفة في ذلك الوقت أصابها الضعف وفقدت بريقها ولم تعد قادرة على إثارة الدهشة.. لم تعد كما كانت. وحتى التلفزيون بات مطيعاً ومنصاعاً للتقنيات الحديثة مثل التطبيقات والمنصّات الرديفة التي وضعته على الرف وفي الهامش. أولئك الفلاسفة اعتبروا التلفازَ، ومن ثم السينما، من ذروات التقنية الحديثة، لكن التكنولوجيا بعد انطلاق عصر الإنترنت تطورت كثيراً وتحوّلت إلى أكسجين يستحيل الاستغناء عنه.. لقد صارت مثل الضوء والماء والهواء.
إن نقطة التحوّل الأساسية ليست في التقنية التي نعيشها الآن بوصفها تحكم أعمالنا وتوجه عمليات التواصل فيما بيننا، وإنما بتحوّلها إلى نمط توريط مستهلك للوقت، فهي تسحبك معها في شبكاتها من معلومةٍ إلى فيديو، إلى مقطعٍ ضاحك، إلى نوادر من محاضرةٍ بالأبيض والأسود، إلى فقرةٍ لحيوانٍ يقفز.. وهكذا دواليك!
فهي تجرّك معها أينما يممت وجهكَ ومهما حاولتَ الإفلاتَ منها. المنظّر في علاقة الإعلام والمجتمع نيل بوستمان ألّف في عام 1985 كتاباً بعنوان: «تسلية أنفسنا حتى الموت: الخطاب العام في عصر العرض التسويقي»، وقد اعتنى به ولخّصه الأستاذ يوسف عسيري لمجلة «حكمة». ومما ورد في الذي كتبه عسيري أن «بوستمان يجادل في كتابه بأنّ التلفزيون كأداة ووسيلة إعلامية نقلت الثقافةَ الأميركية إلى أن أصبحت حلبةً كبيرة من «العرض التسويقي الذي يحتوي على كل ما يهم الشأنَ العامَّ في شتى المجالات، مثل الدين والسياسة والتعليم والاقتصاد وغيرها، حيث أصبح كل ذلك من أجل التسلية».
لكن لماذا صعّد المؤلفُ ضد الإرباك في علاقات التكنولوجيا بالوعي في كتابٍ ألّفه في منتصف الثمانينيات؟! يجيب المترجم عسيري بأن بوستمان «يضرب مثالاً بأن التكنولوجيا للوسيلة الإعلامية هي مثل المخ بالنسبة للعقل، فالتكنولوجيا هي الجزء المادي للمحتوى الذي يمثل المجاز أو المعنى، فجاءت النتيجة غير متعمدة ولا متوقعة للتغير الهائل في التكنولوجيا لأنها غيرت طرائقَ التواصل والنقاش في الرأي العام، واستحالت بذلك إلى عقيدة تفرض نفسَها كنمط للحياة».
وتعليقي على هذا العرض باختصار هو أن التفوّق التكنولوجي، وبلا شك، مؤثر على «بنية الخطاب» وعلى الأسس المعرفية أو أسئلة الحكمة، لكن التكنولوجيا لن تأخذ دورَ الإنسان في بناء الخطاب أو صياغة الحقيقة، وآية ذلك أن التطوّر التقني غيّر من سرعة البحث العلمي، ومن أساليب التعليم، ومن طريقة الاقتناع بالأفكار، إلا أنه لم يذهب بعيداً ليكون صانعاً للخطاب أو مبتكراً للحقيقة. ولا يزال الإنسانُ أقوى من التقنية، حتى وإن لم يسيطر عليها بشكلٍ مطلق. لقد كان هيدغر متنبئاً حين رجّح أن التقنية ستكون مفيدةً ما دامت تحت هيمنة الإنسان وسيطرته، وبرأيي أن الإنسان لا يزال يسيطر حتى على الذكاء الاصطناعي، ولهذا مقالةٌ أخرى.
والخلاصة: إن التفوّق التقني مربك، وربما تشعّبه مقلق، كما أن انفلاته يبدو مزعجاً، وشبكاته التي تطوّقنا تخنقنا، غير أن هذا ثمن تفوّق العقل البشري، وحين نخاف لابد أن نواجه، لا أن نهرب.
GMT 09:29 2026 الخميس ,05 شباط / فبراير
جريمة في حديقةGMT 09:28 2026 الخميس ,05 شباط / فبراير
مفاوضات إيران... «أيُّ الناس تَصفو مَشارِبهُ»؟!GMT 09:27 2026 الخميس ,05 شباط / فبراير
ما وراء الوساطة التركية بين أميركا وإيران!GMT 09:26 2026 الخميس ,05 شباط / فبراير
هل هناك هدنة وشيكة في السودان؟GMT 09:23 2026 الخميس ,05 شباط / فبراير
ليبيا بعد اغتيال سيف الإسلام... سلامٌ على السلامGMT 09:20 2026 الخميس ,05 شباط / فبراير
عن التنافسية الرياضية وآثارها الدنيويّةGMT 09:13 2026 الخميس ,05 شباط / فبراير
سر الملكة إياح حوتبGMT 09:12 2026 الخميس ,05 شباط / فبراير
ذعرٌ من الخصوبةالدولار يتراجع أمام الجنيه المصري وسط إشادة دولية بمسار الإصلاح الاقتصادي
القاهرة ـ العرب اليوم
سجل سعر صرف الدولار الأميركي تراجعاً ملحوظاً أمام الجنيه المصري، خلال تعاملات في مختلف البنوك الحكومية والخاصة، بالتزامن مع مؤشرات إيجابية تعكس تحسناً في أوضاع الاقتصاد الكلي وتقدماً في تنفيذ برنامج الإصلاح الاق...المزيدواتساب تمنع من مشاركة بيانات المستخدمين مع كيانات ميتا الأخرى
واشنطن ـ العرب اليوم
دخلت شركة واتساب، المملوكة لشركة ميتا، في مواجهة قانونية مع لجنة المنافسة الهندية منذ نوفمبر 2024، بعد فرض غرامة مالية عليها بلغت 25.4 مليون دولار، ومنعها من مشاركة بيانات المستخدمين مع كيانات ميتا الأخرى لأغراض إ�...المزيدجدل في معرض القاهرة الدولي للكتاب بعد ظهور روايات مكتوبة بالكامل بالذكاء الاصطناعي
القاهرة ـ العرب اليوم
تصاعد الجدل في معرض القاهرة الدولي للكتاب، بعد اكتشاف روايات كتبت بالكامل باستخدام الذكاء الاصطناعي، وصدرت كما هي من دون مراجعة كافية وتنقيح من "الكاتب". وأظهرت صور متداولة، أن بعض النصوص احتوت على رسائل وتعل...المزيد Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2025 ©
Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2025 ©