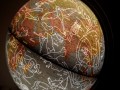الرئيسية
أخبارعاجلة
رياضة
- الأخبار الرياضية
- أخبار الرياضة
- فيديو أخبار الرياضة
- نجوم الملاعب
- أخبار الرياضة
- ملاعب عربية وعالمية
- بطولات
- أخبار الأندية العربية
- مقابلات
- رياضة عربية
- رياضة عالمية
- موجب
- سالب
- مباريات ونتائج
- كرة الطائرة
- كرة اليد
- كرة السلة
- رمي
- قفز
- الجري
- تنس
- سيارات
- غولف
- سباق الخيل
- مصارعة
- جمباز
- أخبار المنتخبات
- تحقيقات
- مدونات
- أخبار المحترفين
- غاليري
ثقافة
إقتصاد
فن وموسيقى
أزياء
صحة وتغذية
سياحة وسفر
ديكور
فلسطين... الفجوة المتسعة بين الشعب والسلطة ينبغي أن تزول
فلسطين... الفجوة المتسعة بين الشعب والسلطة ينبغي أن تزول

بقلم : نبيل عمرو
لو جلست مع أي من المسؤولين في السلطة الفلسطينية، من أصغر موظفٍ في وزاراتها، وجنودها وضباطها، إلى من يسمّون مسؤولي الصف الأول، إلى أعضاء الحكومة... فإنك تجد إجماعاً مطلقاً على التذمر من السلطة، وانتقاد أدائها على جميع المستويات، وهذا أنتج مناخاً مواتياً يصلح للاستخدام من قبل إسرائيل التي تعترض أساساً على وجود السلطة وليس أداءها، كما يصلح لتبرير الدعوات، محقةً كانت أم مغرضة، من قبل من يدعون لإصلاحها كشرطٍ للتعامل السياسي معها.
التذمر العام من السلطة، وبلوغه مستوًى مقلقاً كحالةٍ رسميةٍ وشعبيةٍ عامة، تبلور في وقتٍ بلغت فيه جهود إسرائيل لتصفية الحقوق الفلسطينية أقصى مدى، من حيث القرارات والسلوك، ونظراً للانقسام المأساوي الذي وضع الضفة وغزة تحت نظامين عاجزين عن توحيد الوطن، بل عاجزين عن إدارة كل ما يقع تحت مسؤولياتهما؛ فقد تعمّق الانقسام في الواقع، ما وفّر للخصم المفترض أن يكون مشتركاً فرصةً نادرةً لإحكام السيطرة ليس فقط على السلطة ومساحات حضورها الضيقة أصلاً في الضفة، وكذلك الأمر بصورةٍ مباشرةٍ في غزة، حتى أصبحت إسرائيل في وضع المقرر، بدءاً من عدد من يدخل ويخرج من معبر رفح، إلى التدخل في كل تفصيلةٍ تتعلق بالضفة وأهلها.
الملاحظ أنَّ الوضع الإقليمي والدولي للحالة الفلسطينية أقوى بكثيرٍ من الحالة المحلية، وهذا أمرٌ يصل إلى حد الكارثة، ما دام الانقسام مستمراً بين من يتصدرون المشهد في الضفة، وأولئك الذين يتصدرونه فيما تبقى من غزة، وما دام الطرفان لا يبذلان أي جهدٍ ولو بحدودٍ دنيا لإنهاء الانقسام وتوحيد الوطن وأهله تحت شرعيةٍ واحدةٍ تمتلك المؤهل للتحدث باسم الجميع.
الانقسام الذي أعيا العالم في محاولات معالجته بما يقارب العشرين سنة، والذي ازداد وتعمّق رغم الحالة الكارثية المفروضة على الشعب الفلسطيني، أفرز حالة أخرى وهي سعي كل طرف من أطرافه إلى حل مشكلاته الخاصة؛ إذ لا رابط بين الطرفين سوى أنَّ إسرائيل تفرض على كليهما ما تستطيع من أجنداتها، وليس لهما سوى الصراخ والشكوى خشية فقدان ما تبقى لهما في الضفة وغزة.
لا أحبُّ إلقاء اللوم على إسرائيل وحدَها في ما تخطط وتفعل، فذلك وإن كان مؤثراً في كل المسارات الفلسطينية، وما يتصل بها من إقليميةٍ ودولية، فإن ما يتعيَّن على الطبقة السياسية الفلسطينية فعله، ولم تفعل، يتقدم في المسؤولية على ما تتحمله إسرائيل، ذلك وفق مبدأ: إذا كانت إسرائيل عملت على إنتاج الانقسام وإدامته، فعلى قوى الواجهة الفلسطينية مسؤولية إنهائه.
عامل الوقت في هذه الحالة يبدو مؤثراً رئيسياً منذ البداية، ذلك أن عدم إنهاء الانقسام وهو في مهده راكم معطياتٍ كارثية، لم تتوقف عند الخسارات البشرية والسياسية التي نتجت بفعله على مدى سنواته العديدة والمديدة، بل وصلت إلى حدّ وضع المنجزات الفلسطينية التي تحققت بشقّ الأنفس وفداحة التضحيات في مهب الريح، ولسنا بحاجةٍ لسَوق براهين على ذلك.
يتساءل الفلسطينيون بعد كلّ ما حدث والذي لم تتوقف مفاعيله الكارثية حتى الآن: ما العمل؟ وكيف يخرجون من هذه الحالة إن لم يكن من أجل تحقيق الأهداف الكبرى، فمن أجل حماية الحقوق من التبدد وإبقاء القضية على قيد الحياة؟
بفعلٍ عربيٍّ وإقليميٍّ ودولي، أُغلقت الدائرة الخارجية على إنجازٍ تاريخي تحقق على مسار الهدف الأصعب، ولكنَّه الأهم، وهو قيام الدولة الفلسطينية على الأرض التي احتُلت في عام 1967، بما في ذلك القدس الشرقية. ولقد تجاوز التقدم على هذا المسار حدود الإقرار بالحق إلى الاعتراف الكامل والصريح بالدولة. ومما يبدو غير منطقي ولا مفهوم هو الفرق العميق والواسع بين الإرادة الدولية الشاملة نحو حتمية قيام الدولة، وبين التباطؤ الفلسطيني في ترتيب الوضع الداخلي وتوحيده، وبالأخص توحيد شرعيته. وأمرٌ آخر غير منطقيٍّ وغير مفهوم، هو اتساع الفجوة بين الشعب الفلسطيني وبين من يُفترض أنهم قيادته وممثلوه.
هذا الشعب قدّم كل ما هو مطلوب منه لحماية حقوقه بالصمود المعجز على الأرض، والتحمل الذي لا طاقة لبشرٍ على تحمله؛ إذ لم يعد التهجير الذي هو أساس البرنامج الإسرائيلي وارداً ولا حتى ممكناً، ولم تعد البلاد لقمةً سائغةً يبتلعها المحتل لمجرد اتخاذه قراراتٍ بذلك.
إن الفجوة المتسعة بين الشعب القوي وسلطته ينبغي أن تزول، ذلك أن أسلحة إسرائيل الفتّاكة التي لم تتوقف عن العمل ضد الفلسطينيين منذ بدايات القرن الماضي وحتى أيامنا هذه، لم تنجح في إنهاء القضية رغم رهانها على تدمير الحالة الفلسطينية من داخلها، التي هي في الواقع مركز الضعف أو القوة في مسألة الصراع الدائم في الشرق الأوسط، ومكانة القضية الفلسطينية فيه. الفضل في ذلك حتى الآن يعود إلى الشعب القوي وتلقائية مبادراته في حماية حقوقه وآماله.
GMT 07:30 2026 الإثنين ,16 شباط / فبراير
تجديد الحياة السياسية..GMT 03:39 2026 الإثنين ,16 شباط / فبراير
إيران والمكابرة… على طريقة صدّامGMT 03:38 2026 الإثنين ,16 شباط / فبراير
روبيو في ميونيخ: الاتّهام المخمليّ لأوروباGMT 03:35 2026 الإثنين ,16 شباط / فبراير
سلام وخناجرGMT 03:34 2026 الإثنين ,16 شباط / فبراير
ترمب وإعادة إيرانَ إلى إيرانGMT 03:32 2026 الإثنين ,16 شباط / فبراير
من أساطير الأوَّلين للآخرينGMT 03:30 2026 الإثنين ,16 شباط / فبراير
معنى الحياة فى ذكرى هيكل العاشرةGMT 03:29 2026 الإثنين ,16 شباط / فبراير
الملك المصرى على مسرح أنفيلدالرئيس الأميركي يعلن تعزيز القدرة الشرائية للمواطنين ويؤكد نجاح سياساته الاقتصادية
واشنطن ـ العرب اليوم
أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مؤخراً أن سياسات إدارته الاقتصادية أسهمت بشكل ملموس في تعزيز القدرة الشرائية للمواطنين، مؤكدًا أن الإجراءات التي تم اتخاذها خلال السنوات الماضية أدت إلى تحسين مستوى المعيشة، وخف...المزيدمحمد هنيدي يؤكد حرصه على إبعاد الجمهور عن خلافاته المهنية
القاهرة - العرب اليوم
أكد الفنان محمد هنيدي حرصه على إبقاء أي خلافات مهنية بعيدًا عن أعين الجمهور ووسائل الإعلام، مشددًا على أن عدم رده على ما قد يُثار من تصريحات لا يعكس ضعفًا، وإنما قناعة بأن الجمهور يجب أن ينشغل بأعماله الفنية فقط لا �...المزيدشكوى قانونية ضد شركة غوغل الأميركية بسبب تقليد الصوت بالذكاء الاصطناعي
واشنطن ـ العرب اليوم
أثارت شركة غوغل الأميركية جدلاً واسعاً بعد أن قدّم مذيع أمريكي معروف شكوى قانونية ضد الشركة، مدّعياً أن أداة ذكاء اصطناعي طوّرتها جوجل استنسخت صوته بدقة عالية دون إذن أو تعويض. المذيع أكّد أن التقنية الجديدة قاد...المزيد Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2025 ©
Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2025 ©