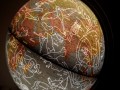الرئيسية
أخبارعاجلة
رياضة
- الأخبار الرياضية
- أخبار الرياضة
- فيديو أخبار الرياضة
- نجوم الملاعب
- أخبار الرياضة
- ملاعب عربية وعالمية
- بطولات
- أخبار الأندية العربية
- مقابلات
- رياضة عربية
- رياضة عالمية
- موجب
- سالب
- مباريات ونتائج
- كرة الطائرة
- كرة اليد
- كرة السلة
- رمي
- قفز
- الجري
- تنس
- سيارات
- غولف
- سباق الخيل
- مصارعة
- جمباز
- أخبار المنتخبات
- تحقيقات
- مدونات
- أخبار المحترفين
- غاليري
ثقافة
إقتصاد
فن وموسيقى
أزياء
صحة وتغذية
سياحة وسفر
ديكور
زيارة لم تبدّد قلقَ نتنياهو
زيارة لم تبدّد قلقَ نتنياهو

بقلم : سام منسى
يتعذّر وصف زيارة بنيامين نتنياهو إلى واشنطن الأسبوع الماضي بالناجحة أو الفاشلة دون معرفة خبايا لم تُعلن عن الاجتماع مع الرئيس دونالد ترمب، ومن السذاجة أيضاً الاعتقاد أن التباينات، مهما بلغت، قد تخرب العلاقة المتينة بين الطرفين. هذا لا يمنع تصاعد قلق إسرائيل من المفاوضات الجارية مع إيران، لا لأن التفاوض بحد ذاته مفاجأة، بل لأن السياق الإقليمي والدولي الذي يجري فيه يضعها أمام معادلة حرجة: احتمال عودة الدبلوماسية بين الولايات المتحدة وإيران بدعم إقليمي، في لحظة تشعر فيها بأن قدرتها على فرض مقاربتها الأمنية الأحادية تتآكل.
القلق الإسرائيلي لا يتركز فقط على مضمون أي اتفاق محتمل، بل على فكرة الاتفاق نفسها. فمنذ سنوات، بُنيت العقيدة الأمنية الإسرائيلية على منع إيران من التحول إلى قوة نووية كامنة أو «دولة عتبة»، وعلى إبقاء الملف الإيراني ضمن خانة التهديد الوجودي الذي يبرر سياسات الردع القصوى. أي مسار تفاوضي يعيد إدماج إيران تدريجياً في النظام الدولي تنظر إليه إسرائيل كأنه مس مباشر بهذه العقيدة، حتى لو تضمن قيوداً على البرنامج النووي.
تجربة الاتفاق النووي لعام 2015 لا تزال حاضرة بقوة في الوعي السياسي الإسرائيلي. بالنسبة لتل أبيب، لم يُنهِ الاتفاق الخطر بل أجّله، وسمح لإيران بالتقاط أنفاسها اقتصادياً وسياسياً من دون معالجة سلوكها الإقليمي أو برامجها الصاروخية. اليوم، تخشى إسرائيل حدوث سيناريو مشابه يخفف الضغوط الاقتصادية عن إيران ويتيح لها إعادة تنظيم نفوذها الإقليمي، في ظل رغبة أميركية لصفقة تخفض التوتر وتجنب الانزلاق إلى مواجهة عسكرية مفتوحة.
والقلق الإسرائيلي لا يتعلق بإيران وحدها، بل بالتحول في المقاربة الأميركية نفسها. فالمفاوضات تعكس توجهاً أوسع في واشنطن نحو إدارة الصراعات بدل حسمها، وتفضيل التسويات المرحلية على المواجهات المفتوحة. هذا المنطق يتعارض مع الرؤية الإسرائيلية القائمة على الضغط المستمر والردع العسكري ومنع الخصم من إعادة التموضع. لذلك، أي تقارب أميركي - إيراني يُقرأ في تل أبيب كأنه إشارة إلى تراجع الاستعداد الأميركي لاعتماد الخطوط الحمراء الإسرائيلية بوصفها مرجعية مطلقة.
يضاف إلى ذلك تباين مواقف الدول العربية التي لا تشارك إسرائيل مستوى القلق نفسه إزاء المفاوضات، إذ يرى عدد منها أنها وسيلة لخفض منسوب التوتر الإقليمي، لا أنها تهديد مباشر لأمنه واستقراره. في ظل أولويات عربية باتت تركز على الاستقرار الاقتصادي، وجذب الاستثمارات، وضبط المخاطر.
مع مقاربة أميركية لا تأخذ بالكامل الهواجس الإسرائيلية بالاعتبار، وفي ظل واقع إقليمي جديد يتميز بعلاقات تطبيعية قائمة مع البعض دون أن تتحول تلقائياً إلى تحالفات استراتيجية صلبة عند كل منعطف أمني، يتعمق قلق إسرائيل ليتجاوز مضمون المفاوضات ويطول موقعها في المعادلة الإقليمية والدولية. تل أبيب التي اعتادت لعب دور الطرف المُقرر في ملفات الأمن والردع، تجد نفسها اليوم أسيرة توازنات لا تتحكم فيها وحدها، وأمام مسار تفاوضي يُدار فوقها ولا تسيطر على إيقاعه، حتى يبدو القلق في كثير من الأحيان تعبيراً عن فقدان السيطرة.
ومع تفاقم الانقسام السياسي والمجتمعي، يبرز البُعد الداخلي الإسرائيلي في تفسير القلق من مسار المفاوضات إذ باتت المخاوف منها انعكاساً لأزمة داخلية بقدر ما هي هواجس أمنية. في هذا السياق، تعيد حكومة نتنياهو توظيف «الخطر الإيراني» لإنتاج حد أدنى من الإجماع وتأجيل الخلافات حول القيادة ومستقبل النظام السياسي، في سلوك يكشف مأزقاً بنيوياً: حكومة تكتفي بإدارة مناخ القلق وتغذيته سياسياً بدل بلورة رؤية استراتيجية طويلة الأمد للتعامل مع التحولات الإقليمية.
هل تملك إسرائيل بدائل فعلية عن سياسة القلق والتصعيد؟ تبدو الخيارات محدودة: فالحرب كما يفضلها نتنياهو تكلفتها باهظة وتبدو غير مرجحة، والضغط السياسي على واشنطن له سقوفه، والرهان على جبهة إقليمية موحدة يتآكل.
غير أن ضيق البدائل لن يغير سياسة نتنياهو القائمة على معادلة بسيطة: إما تسويات تصاغ وفق توقيته وعلى قياس حساباته السياسية والشخصية، وإما الحلول الرمادية: إنهاك «حماس» دون القضاء عليها، وتقويض قدرات «حزب الله» وتركه قادراً على زعزعة استقرار لبنان، وتقليم أظافر إيران دون نزعها من المعادلة الإقليمية.
في ظل هذه المعطيات، قد يسعى نتنياهو إلى دفع واشنطن نحو صيغة وسط: إبرام اتفاق يركز على الأنشطة النووية بما يمنح ترمب إنجازاً يريده ومخرجاً من الحرب، مقابل هامش أوسع لإسرائيل للتحرك عسكرياً ضد الصواريخ والأذرع الإيرانية المحيطة بها. أي تسوية مؤقتة ترضي الطرفين لكنها تؤجل الإشكال بدل حسمه.
بالمحصلة، القلق حالة دفاعية تستثمر لكنه لا يشكل سياسة ولا استراتيجية بديلة تواكب التحولات المتسارعة، ما يبدده هو الأمر الذي ترفضه إسرائيل: انخراطها في سلام إقليمي شامل ودائم، والقبول بالعيش إلى جانب كيان فلسطيني مستقل يعيد للفلسطينيين بعضاً من حقوقهم.
GMT 07:30 2026 الإثنين ,16 شباط / فبراير
تجديد الحياة السياسية..GMT 03:39 2026 الإثنين ,16 شباط / فبراير
إيران والمكابرة… على طريقة صدّامGMT 03:38 2026 الإثنين ,16 شباط / فبراير
روبيو في ميونيخ: الاتّهام المخمليّ لأوروباGMT 03:35 2026 الإثنين ,16 شباط / فبراير
سلام وخناجرGMT 03:34 2026 الإثنين ,16 شباط / فبراير
ترمب وإعادة إيرانَ إلى إيرانGMT 03:32 2026 الإثنين ,16 شباط / فبراير
من أساطير الأوَّلين للآخرينGMT 03:30 2026 الإثنين ,16 شباط / فبراير
معنى الحياة فى ذكرى هيكل العاشرةGMT 03:29 2026 الإثنين ,16 شباط / فبراير
الملك المصرى على مسرح أنفيلدالرئيس الأميركي يعلن تعزيز القدرة الشرائية للمواطنين ويؤكد نجاح سياساته الاقتصادية
واشنطن ـ العرب اليوم
أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مؤخراً أن سياسات إدارته الاقتصادية أسهمت بشكل ملموس في تعزيز القدرة الشرائية للمواطنين، مؤكدًا أن الإجراءات التي تم اتخاذها خلال السنوات الماضية أدت إلى تحسين مستوى المعيشة، وخف...المزيدمحمد هنيدي يؤكد حرصه على إبعاد الجمهور عن خلافاته المهنية
القاهرة - العرب اليوم
أكد الفنان محمد هنيدي حرصه على إبقاء أي خلافات مهنية بعيدًا عن أعين الجمهور ووسائل الإعلام، مشددًا على أن عدم رده على ما قد يُثار من تصريحات لا يعكس ضعفًا، وإنما قناعة بأن الجمهور يجب أن ينشغل بأعماله الفنية فقط لا �...المزيدشكوى قانونية ضد شركة غوغل الأميركية بسبب تقليد الصوت بالذكاء الاصطناعي
واشنطن ـ العرب اليوم
أثارت شركة غوغل الأميركية جدلاً واسعاً بعد أن قدّم مذيع أمريكي معروف شكوى قانونية ضد الشركة، مدّعياً أن أداة ذكاء اصطناعي طوّرتها جوجل استنسخت صوته بدقة عالية دون إذن أو تعويض. المذيع أكّد أن التقنية الجديدة قاد...المزيد Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2025 ©
Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2025 ©